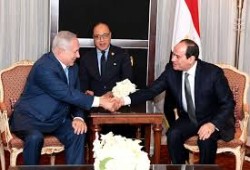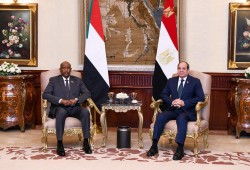لم يكن تحويل مصر من "مخزن غلال العالم القديم" إلى أكبر مستورد للقمح مجرد صدفة تاريخية أو نتاجاً لأزمة مناخية عابرة، بل هو حصاد مر لهندسة سياسية واقتصادية ممنهجة بدأت ملامحها بانقلاب السبعينيات، واستكملت فصولها الكارثية في عهدي مبارك والسيسي. هذا المسار الطويل، الذي رفع شعار "تحرير السوق" بينما كان في الحقيقة "يحرر الريف من فلاحيه"، أعاد تشكيل علاقات الملكية والإنتاج بشكل جذري، ساحقاً صغار المزارعين تحت عجلات الإقطاع الجديد والشركات الرأسمالية.
اليوم، يقف الفلاح المصري محاصراً بين فكّي كماشة لا ترحم: من جهة، أسعار مستلزمات إنتاج جنونية وسياسات تمويلية تحولت من "الدعم" إلى "الجباية والملاحقة القضائية"، ومن جهة أخرى، تشريعات جائرة جرّدته من أمانه الاجتماعي وأرضه. النتيجة الحتمية لهذا التجريف ليست فقط إفقار ملايين الأسر الريفية، بل فقدان الوطن لسيادته الغذائية، ليصبح رهينة كاملة للخارج في رغيف خبزه وقوت يومه.
انقلاب على "الإصلاح": تشريعات الطرد وتفكيك الحماية
بدأت المأساة الحقيقية حين انقلبت الدولة على مكتسبات ثورة يوليو وقانون الإصلاح الزراعي الأول، لتعيد الاعتبار للإقطاع القديم. كانت البداية في أكتوبر 1971 بقرارات السادات لتعويض الإقطاعيين، ثم توالت الضربات وصولاً إلى القانون الكارثي رقم 96 لسنة 1992 في عهد مبارك، الذي حرر العلاقة الإيجارية في الأراضي الزراعية. هذا القانون لم يرفع الإيجارات فحسب (من 7 أمثال الضريبة إلى 22 ضعفاً)، بل منح الملاك حق طرد المستأجرين، مما أدى – وفقاً لتقديرات الدكتور صقر النور – إلى تضرر أكثر من مليون أسرة ريفية، تم إفقارها وتهميشها بضربة واحدة، لتنضم إلى جيوش العاطلين وسكان العشوائيات.
هذا التفكيك التشريعي توازى مع تخريب مؤسسي متعمد؛ فقد أُلغيت "الدورة الزراعية" التي كانت تضمن التوازن بين المحاصيل الاستراتيجية (كالقمح والقطن) والمحاصيل الأخرى. والنتيجة كانت كارثية: انخفضت مساحات القطن من 2 مليون فدان في السبعينيات إلى أقل من 130 ألف فدان اليوم، واندفع المزارعون لزراعة محاصيل تصديرية (فراولة وكانتلوب) على حساب قوت الشعب، في استجابة عمياء لمنطق "السوق الحر" الذي لا يقيم وزناً للأمن القومي.
"مصيدة" الديون والأسمدة: الدولة كـ"سمسار" ضد الفلاح
لم تكتفِ الدولة برفع يدها عن الحماية، بل تورطت في إفقار الفلاح عبر آليات السوق المتوحشة. ففي ملف الأسمدة، تخلت الحكومة عن حصصها في شركات استراتيجية رابحة مثل "أبو قير" و"موبكو" (بيعت حصص منها مقابل 14 مليار جنيه في 2024)، مما ترك السوق فريسة للمحتكرين. وقفزت أسعار اليوريا في السوق السوداء إلى أرقام فلكية (وصلت إلى 25 ألف جنيه للطن في 2025)، بينما الفلاح يستجدي حصته المدعومة التي لا تصل.
وفي ملف التمويل، تحول "بنك التنمية والائتمان الزراعي" – الذي أُسس أصلاً كظهير تعاوني للفلاح – إلى "البنك الزراعي المصري" بالقانون 84 لسنة 2016، ليصبح بنكاً تجارياً يهدف للربح فقط. هذا التحول جعل الفلاحين فريسة لفوائد تتجاوز 20%، وحول البنك من داعم إلى "سجان" يطارد أكثر من 200 ألف فلاح متعثر بأحكام الحبس، بدلاً من جدولة ديونهم. لقد نُزعت الوظيفة الاجتماعية للتمويل الزراعي، وباتت القروض عبئاً يبتلع الأرض والمحصول، ويدفع المزارعين لهجر مهنتهم قسراً هرباً من السجن.
حصاد "التبعية": وطن يأكل مما لا يزرع
النتيجة النهائية لهذه السياسات هي انهيار شامل للقدرة الإنتاجية المصرية. الأرقام ترسم صورة مفزعة لدولة فقدت استقلالها الغذائي: مصر تستورد اليوم 55% من احتياجاتها من القمح (لتصبح أكبر مستورد عالمياً)، وتستورد 50.7% من الذرة، و99.7% من العدس، و95% من الزيوت النباتية. هذه "الفجوة الغذائية" ليست مجرد عجز تجاري، بل هي ثغرة في الأمن القومي تجعل القرار السياسي المصري مرتهناً لمن يملك الغذاء.
الخروج من هذا النفق المظلم لن يتحقق بمزيد من "التحرير" أو بيع أصول الدولة، بل بتغيير جذري في فلسفة الحكم: استعادة الدولة لدورها في حماية المنتج الصغير، عودة الدورة الزراعية لضبط الأولويات، تمكين الفلاحين من تنظيم أنفسهم في نقابات وتعاونيات حقيقية تدافع عن حقوقهم، ووقف تغول الشركات الكبرى. إن الزراعة في مصر ليست مجرد "بيزنس" يدار بمنطق الربح والخسارة، بل هي مسألة "حياة أو موت" لشعب كامل، واستمرار إهمالها يعني أننا ننتظر المجاعة عند أول أزمة عالمية قادمة.