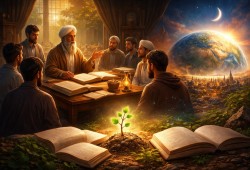أبو نصر محمد شخار
إن كلمات خطاباتنا تستمد تصورها وقيمتها من مدلولها ومعناها، وتُسحضَر الألفاظ لتكشف عن المعاني والمفاهيم التي نودّ بيانها، ولكن تلك المصطلحات والألفاظ ليست مجرد تَمَثُّلٍ بريء للمعنى المعجمي؛ بل هي مستودعات للإيحاءات والانتقاءات والتحيّزات، ومجالٌ لتراكم فلسفة المجتمع والطائفة والأمة، وشخصية الفرد وخلفيته التربوية، حتى اعتَبرت بعضُ التحليلات النفسية أن نفسية الشخص ولاوعيه ليس إلا عالمَ اللغة الذي يسكنه، ويمكن الوقوف على ملامح ذلك الكيان وخصائصه بين زلات كلام الشخص العفوية، وطبيعة اللغة المستخدمة وحتى النكت المنتقاة!
وبغض النظر عن جدلية الفكر واللغة وعلاقتهما ببعضهما عند الفلاسفة وعلماء النفس والاجتماع، وأيهما أسبق من الآخر[i]؛ إلا أن الجميع يلحظ وجود أثر أحدهما على الآخر، فوضوح اللغة وانضباطها ومرونتها تُسهم في وضوح الفكر وثرائه وموضوعيته، كما أن حركية الفكر تؤدي إلى انضباط اللغة ومصطلحاتها ووضوح مفاهيمها، فاللغة ليست مجرد وسيلة للتعبير بل هي جزء من العملية الفكرية، وضبابية اللغة تؤثر على مستوى منهجية التفكير والعكس، لذا كان الاهتمام بملابسات اللغة ومصطلحاتها من أولى الاهتمامات في سبيل ترقية الفكر وتنقيته من المغالطات والاضطراب، كما أن تحديد مفهومات المصطلحات وتحرير محل النزاعات ضرورة ملحّة لتقليص التشنج والاختلافات الفكرية[ii]
واللغة -في الأصل- هي تَمثُّل موضوعي للتصور والفكر واللاوعي، ولكن ذلك التمثُّل تُشوش عليه الذاتية والرغبة والتقليد والهوى، فتهتزّ تلك الموضوعية من خلال التحيزات والانتقائية، ويتم تحريف العلاقة بين الدال (اللفظ) والمدلول (المعنى)، لتتحول اللغة الخطابية إلى لغة طائفية دوغمائية، يصعب التحرر من أغلالها.
فالعلاقة بين الدال والمدلول تتشكل تحت توجيه وعي المتكلم، ولا يفرق بين كلام الآلة والببغاء وكلام الإنسان إلا الوعي والقصدية، ولكن اللغة تتشكل ابتداء بالربط اللاواعي للطفل بين الدال والمدلول تقليدا للجو العائلي والمجتمعي الذي نشأ فيه، والأصل أن الطفل عندما يبلغ مرحلة الرشد يحوِّل ذلك الربط إلى علاقة واعية، لمراقبة المصطلحات والمفاهيم والإيحاءات المرتبطة بها، ولكن في ظل التقليد الأعمى ينتقل المقلد –بعد طفولته- إلى مرحلة لاوعي أخرى يمثلها المجتمع أو المذهب الفكري، فيردّد ما يُملى عليه كما الآلة اللاواعية، فتتبلد فيه حاسة الوعي تجاه ما يسمع من الخطابات، ولا ينساق إلا لما شكّله الوعي الجمعي[iii]
والخطاب في الأدبيات الدينية المختلفة يشكل محور الاهتمام، فبه تنفتح أبواب السماء، وبه تصاغ تعاويذ السحر المدمرة! وبه يُرفع أقوام إلى القدسية المطلقة، ويُخفض آخرون ويهلكون، وبه تُضمن الجنان وتُقتنص أموال الأمراء...، حتى أضحى اللفظ أحيانا أشرف من المدلول، وأصبح القول –عند البعض- يغني عن العمل.
ولقد كان لمباحث الألفاظ في أصول الفقه فضل في الإسهام في ضبط اللغة الشرعية، ومراقبة عملية المرور من الدال إلى المدلول، ولكنها -كما يبدو لنا- غلت في الأشكال اللفظية ولم تحظ بعقلنة حقيقية للمدلولات، ولم تعتن كثيرا بالملابسات والنزعات النفسية التي قد تؤدي إلى امتهان الأشكال اللفظية لغير مقصدها؛ لذلك نجد من اتخذ تلك القوالب الشكلية نفسها وسيلة لتكريس التقليد والانتصار للأئمة والمذاهب، واتخذها آخرون وسيلة للتحايل على أحكام الشرع، من هنا كانت أهمية إسهام النظرة المقصدية –عند الشاطبي وغيره- على تكريس مزيد من أخلاقية الاستنباط، من خلال ضبط قصد المستنبط بمقاصد الشريعة، ومراقبة قصد المكلف حين العمل.
ففي المصطلحات الأصولية نجد بعض التقعيدات تؤول في النهاية إلى أداة مذهبية، فمفهوم القطع والظن –مثلا- ورغم التأصيل له بقواعد مضبوطة في الظاهر، لكنها تؤول في النهاية إلى وسيلة للتقليد وتكريس الفرق، فالمفهوم بُني على طريقة دورانية لا تؤسس نقدا داخليا للمسائل، فالمسألة القطعية هي ما ثبت بنص قاطعٍ دلالةً وثبوتًا، والمسألة القطعية لا يجوز الخلاف فيها، ومبتدعٌ ضالٌّ من خالف "الحق" فيها، ولكن كيف يمكن معرفة دلالة القطع والثبوت في النص؟ بالنسبة للعامة يؤول أمرهم إلى تقليد علمائهم، وبالنسبة للعلماء عليهم تبرير أقوال أئمتهم وعدم الخروج عن اختياراتهم، فتبقى تلك القواعد تبريرية أكثر منها قواعد كاشفة ناقدة، فيُتوارث ذلك القطع! اجتماعيا عبر أجيال من التقليد، حتى أصبح "الحق" في وعي كثير من الناس مطابقا للأنا، ودرجة أحقية الآخر هي بمقدار قربه وبعده من دائرتهم!
وقد تتخذ اللغة مظهرا سوفسطائيا مشحونا بالعواطف وحشو الكلمات، الهدف منها تكثير الأتباع وليس ابتغاء الحقيقة، فيمكن للجاهل البليغ أن يقنع الجمهور بما تنقضه الحقائق العلمية، ولعل هذا سر إدانة أفلاطون للبلاغة لأنها تضيّق من مساحة التفكير لحساب العواطف والمغالطات، فكثير من الاختلافات تحسبها خلافات حقيقية لكن إن غُصْت في منطلقاتها التصورية والاصطلاحية فلن تجد إلا أوهاما في المصطلحات التي نحتتها اللغة المذهبية، وليس الدافع إلى النقاش دوما بيان القناعة أو البحث عن الحقيقة، فقد يكون الدافع هو الحفاظ على موروث وُرِث من الآباء والأجداد، فيُلقى في روع الخلف أنهم مسؤولون عن تمريره إلى من يليهم وإلا فقد ضيّعوا الأمانة! والذي يسهم في ضمان حمل تلك الأمانة وعدم النظر فيها بعين النقد والتمحيص هو "المودة الاجتماعية" و"العلاقات المصلحية" التي ترتبط غالبا بجملة من المعتقدات والتصورات يتشارك المجتمع في حمايتها بوعي وبغير وعي، فتكون ضريبة نقدها مكلفة، وقد صدق خليل الرحمن لما فضح ذلك المنزع النفسي والاجتماعي: "وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ"[iv]
،فهل نحن مستعدون لنُخضع موداتنا وعلاقاتنا الاجتماعية ومصالحنا إلى الحق وليس العكس؟
ومن دون نية صادقة لتحليل المسائل المختلف فيها، والوقوف على تحرير محل النزاع الحقيقي فيها، وتفكيك الخطاب الديني الذي يسوّق تلك المسائل للأتباع فإنه سيبقى المسلمون يجترون المسائل نفسها، والكل غير مستعد أن يتنازل عن تراث الأجداد، فتُوظف–تبعا لذلك- مفاهيم: التجرّد والبحث عن الحق وعدم التقليد في الأصول... في سياق توصيف ضلال الآخر وعصمة الذات، فيؤول الأمر إلى حرب المصطلحات، كما تُتَوسَّل توصيفات أخرى للتشويه والقدح في الآخر كالمبتدع والعقلاني والعلماني والليبرالي والخارجي والرافضي والناصبي والقرآني والحداثي والمتشدد والأصولي والروائي والأثري والمخالف...، فيؤول الأمر إلى لعبة مصطلحية ولغوية لا أخلاقية، الغرض منها مجرد القدح والتنابز، ويصعب أن تجد لتلك اللغة الخطابية ضبطا متفقا عليه بين المختلفين، وتبقى الأزمة ما دامت تلك اللغة الوهمية سائدة.
فلغتنا الدينية الخطابية أصبحت لغة متشنجة مشحونة بتلك المصطلحات الموهِمة، فلم تعد لغة علمية واضحة دقيقة تهدف إلى استكناه جوهر الأمور والوقوف على الحق، مع الاستعداد الخالص للتنازل له، ولكنها أضحت ذات وظيفة "أدائية" ترمي إلى حماية الجماعة والطائفة والمصالح المتعلقة بذلك، وسُيّجت تلك الأفكار بسياج فكري واجتماعي يُرهب عن التفكير والنقد، حتى صار الشاك في شيءٍ هالك، والشاك في الشاك هالك!
والأمر يستدعي جرأة على مناقشة المنهج من أساسه ومحاكمته إلى الوحي الإلهي وقواعد العقل والمنطق، فالمنهج قد يكون أحيانا الحاجز الأكبر عن الحقيقة، لأن الفكر عندما يشتغل ضمن إطار منهجي معين، فإنه غالبا ما يفكر بــــــالمنهج ولا يعيد التفكير فــــــــيه، فيكون في النهاية أداة مانعة عن التجرد.
وفي ظل تشكل هذا الخطاب المفعم بالمصطلحات الفضفاضة تحوّل الخطاب الديني –في عمومه[v]
-إلى خطاب سطحي منبثّ عن الواقع، يعمل على تكثير الأتباع وتحصينهم من الآخر، ولا يعمل إلا على مستوى الألفاظ (الظاهرة الصوتية!)، مركّزا على مسائل فرز الذات عن الغير–وكثير منها مسائل شكلية-، فتجده -بذلك- مفرغا من المضامين الحضارية والإنسانية، وغائبا عن مسايرة التحولات الكبرى؛ النفسية والاجتماعية والسياسية والأخلاقية للمجتمع، فتسمع آلاف الساعات في الفضائيات عن مسائل الفقه الجزئية، وآلافا أخرى عن حكاية أمجاد الغابرين وقصصهم –إن صحت-، وعن مواعظ عامة فضفاضة لا يكلّف صاحبها نفسه جهدا عقليا بحثيا ولا مسحا ميدانيا لملابسات الواقع وقياس وعي الناس، والوقوف على ما يؤثر فيهم بالإحصاءات والأرقام، والاستعانة بأدوات العلوم الإنسانية المختلفة كعلم الاجتماع والنفس والاقتصاد وغيرها، وهذا يستدعي قبل ذلك أسلمة منطلقات تلك العلوم، وفي ظل هذه القطيعة العلمية فلست أنتظر من الخطاب الديني أن تكون له الأهلية لإنشاء بيئة اجتماعية عادلة أو نظام مالي إسلامي يزاحم النظام الربوي الغربي الذي تسنده عشرات العلوم الدقيقة ومئات الجامعات المتمرّسة وآلاف العقول الجبارة، اللهم إلا أن يكون نظاما محاكيا له في جوهره، مؤسّسا على ضروب الحيل والتفكير الجزئي الشكلي التحايلي.
وفي المقابل نجد الخطاب المهيمن في بعض البلاد -التي تحترم نفسها!- مستندا إلى ترسانة من مراكز البحث والدراسات الميدانية والاستراتيجية ومؤسسات سبر الآراء التي تتابع وعي الناس أولا بأول، لتعيد صياغته -بأذكى طرق التوجيه النفسي والاجتماعي- إلى مقاصدها الحضارية، وليست دوما مقاصد محمودة.
ولا ريب أن الخطاب الإسلامي له مسؤولية كبيرة في توجيه الأمة الإسلامية إلى بناء الحضارة التي تجسّد الخلافة الإلهية في الأرض، تحت سقف الأخلاق القرآنية وأحكامه، لتُحقِّق العدالة، ولتكون بلسما للمظلومين والفقراء والمعدمين، وليس المطلوب هو خطابات حماسية عن العمل والإنتاج، وإنما المطلوب إعادة تشكيل أولويات هذا الخطاب وأنسنته ليكون أقرب إلى متابعة وعي الناس، ومفعما بمفاهيم الأخلاق والعدالة والحضارة، ولست أنتظر من خطاب ديني أن يسهم في رفع وعي الأمة الحضاري إن كانت قضاياه المحورية التي بها يقرّب ويُبعد، وبها يتولى ويتبرأ هي مسائل شكلية فرعية!
ولقد أشار عالم الاجتماع ماكس فيبر إلى أهمية الخطاب الديني في التوجيه الحضاري للمجتمعات[vi]
، ولاحظ أن أخلاق المذهب البروتستانتي الألصق بالواقع والأكثر أنسنة من أصلها الكاثوليكي هي سبب النهضة المدنية في الغرب، فإن كانت تلك العملية الإصلاحية تلوثت بانحرافات عقدية وأخلاقية، فالواجب علينا أن نعمل على التأسيس لنموذج إسلامي متوازن. وليس في انحرافهم مبرر للتخويف من كل إصلاح وتغيير، فلست أفهم منطق من يشمت في ضريبة التحولات الحضارية الغربية ولا يتورع عن التنعّم بمنتجات تلك الحضارة في دقائق أمور حياته اليومية، فبقينا بذلك أسرى لأوهامنا وعبيدا لإنتاج الآخرين وسيادتهم.
وفي هذه اللعبة الخطابية نجد أمما تتكلم عن أحلامها الحضارية وتجسّدها في فنها وأفلامها ودعايتها، وأمم لا تزال تعيش خطابا مرهونا بماضيها وأمجاده-مع ما فيه من التدليس!-، ومهوسا ببعض المسائل الدينية التي يُفترض أن تكون صبغةً لحضارة الأمة لا ملهاة عنها، فلم يبق لأفراد الأمة خيارات كثيرة؛ فإما أن يضبطوا الموجة على إنجازات الآخرين وأحلامهم وواقعيتهم المجسدة في خطاباتهم ومعاملهم وحتى فنهم وأفلامهم-مع ما في ذلك من الخطل التصوري والأخلاقي-، وإما أن يضبطوا الموجة على خطاباتنا المفرغة -عموما- من المضامين الواقعية الحضارية.