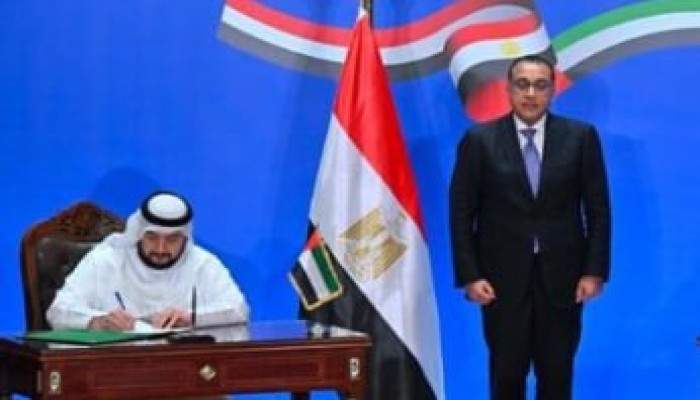تعتزم الحكومة المصرية إتمام صفقة بيع محطة طاقة الرياح في جبل الزيت بقدرة 580 ميجاوات لصالح شركة «ألكازار إنيرجي» الإماراتية، بقيمة تتجاوز 420 مليون دولار، في واحدة من أكبر صفقات برنامج طروحات الأصول الحكومية خلال السنوات الأخيرة. على الورق، تبدو الصفقة «نجاحًا استثماريًا»؛ سعر أعلى من بعض التقييمات الأولية، وتدفق دولارات الاقتصاد بأمسّ الحاجة إليها. لكن خلف هذا الخطاب الرسمي، يطرح اقتصاديون وسياسيون أسئلة حادة: لماذا تُباع أصول مكتملة ومربحة بدلًا من جذب استثمارات جديدة؟ ولمصلحة من تُمنح شركة إماراتية السيطرة على أحد أهم مشروعات الطاقة المتجددة في مصر، وبشروط تسعير للكهرباء بالدولار لسنوات قادمة؟
صفقة بمئات الملايين.. من المستفيد الحقيقي؟
محطة جبل الزيت للرياح ليست أصلًا هامشيًا يمكن التفريط فيه بسهولة؛ نحن أمام مشروع بقدرة 580 ميجاوات، تم تمويله وتشغيله بأموال وقروض وتحملها دافع الضرائب، ليُطرح اليوم في سوق الطروحات كسلعة جاهزة على الرف، يحصل عليها مستثمر أجنبي مقابل 420 مليون دولار تقريبًا. الحكومة ستُعلِن أن الصفقة «أعلى من التقييمات الأولية» وأنها تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، لكن السؤال الجوهري يبقى: هل هذا بيع عادل لأصل استراتيجي أم تصفية تحت ضغط العطش الدائم للدولار؟
الأخطر في بنية الصفقة أن تسعير الكهرباء المنتَجة من المحطة سيكون بالدولار، وإن كانت المدفوعات تُسدد بالجنيه وفق سعر الصرف وقت الدفع. هذا النموذج المالي يعني ببساطة أن الدولة تتحمل ضمنيًا مخاطر أي تراجع جديد في قيمة الجنيه؛ فكل انخفاض في سعر العملة المحلية سيرفع فعليًا تكلفة شراء الكهرباء من المستثمر الجديد، ويخنق ميزانية قطاع الكهرباء والمؤسسات العامة المرتبطة به. نحن إذن أمام عقد طويل الأجل يضمن عائدًا دولاريًا مستقرًا للمستثمر الإماراتي، مقابل تحميل الخزانة المصرية مخاطر سعر الصرف والالتزام بالعقد تحت أي ظرف.
في ظل غياب شفافية كاملة حول مدة العقد، وسعر شراء الكيلووات ساعة، وحجم العائد السنوي المتوقع للمستثمر، يصبح الاحتفاء بالـ 420 مليون دولار أشبه بتسويق لربح قصير الأجل، يُخفي وراءه كلفة طويلة الأمد ستدفعها الأجيال القادمة في صورة التزامات مالية مقننة لا يمكن التراجع عنها.
من «الاستثمار» إلى التمركز الإماراتي في أصول استراتيجية
صفقة جبل الزيت ليست حادثة معزولة؛ إنها حلقة جديدة في سلسلة تمدد إماراتي في مفاصل الاقتصاد المصري، من الموانئ والمناطق اللوجستية إلى العقار والسياحة والطاقة المتجددة. فبحسب بيانات رسمية، ارتفعت الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى نحو 2.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، مع توسع لافت في صفقات الأصول والطروحات الحكومية، وليس فقط في مشروعات جديدة من الصفر.
مشروع مدينة «رأس الحكمة» الساحلية، على سبيل المثال، أصبح نموذجًا صارخًا لتحالف المال الإماراتي مع السلطة السياسية في القاهرة؛ عقد ضخم يسيطر على واحدة من أهم بقاع الساحل الشمالي لعقود قادمة، مع أسئلة مفتوحة حول حجم العائد الحقيقي على الاقتصاد المحلي، ومَن المستفيد الأكبر من إعادة توزيع الثروة العقارية في هذه المنطقة. واليوم، تأتي صفقة جبل الزيت لتوسع هذا النمط: بيع أصول جاهزة في الطاقة المتجددة، بعد أن تحملت الدولة تكلفة الإنشاء والمخاطر الأولى، ليأتي المستثمر الأجنبي على قاعدة «استلام المفتاح» بعوائد مضمونة ودولارية.
الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، يرى أن الاستثمارات الإماراتية لعبت بالفعل دورًا في توفير سيولة دولارية ودعم ميزان المدفوعات، وأن مشروعات كبرى مثل رأس الحكمة يمكن أن تحفّز استثمارات إضافية وتخلق فرص عمل في قطاعات المقاولات والخدمات. لكن هذا الرأي، الذي تتبناه الحكومة أيضًا، يتجاهل سؤالًا حاسمًا: ماذا عن «عمق» التكامل الاقتصادي؟ هل تتحول هذه الاستثمارات إلى قدرة إنتاجية حقيقية وصادرات مستدامة، أم أنها مجرد دورة أموال بين عقار وسياحة وطاقة تضمن عوائد عالية للمستثمر، وتترك الاقتصاد المصري في الهامش كمستقبِل للإيجارات والرسوم؟
محللون آخرون يحذرون من أن اعتماد الاقتصاد المصري المتزايد على الاستثمارات الخليجية عمومًا، والإماراتية خصوصًا، يعكس هشاشة بنيوية؛ ما دامت التدفقات مركزة في بيع أصول أو مشروعات بنية تحتية جاهزة، وليس في توطين صناعة أو نقل تكنولوجيا أو بناء قاعدة إنتاجية تُقلّص العجز التجاري وتخلق وظائف مستقرة. في هذه الحالة، تصبح الإمارات ليست مجرد مستثمر، بل لاعبًا مهيمنًا يتحكم في نقاط حساسة: من الكهرباء إلى الأراضي الساحلية إلى الخدمات اللوجستية، في بلد يعاني أصلًا من أزمة سيادة اقتصادية.
سيولة اليوم مقابل سيادة الغد.. أسئلة معلّقة بلا إجابة
وفق الخطاب الرسمي، صفقة جبل الزيت «تخفف الضغط عن الاحتياطي الأجنبي» وتدعم «برنامج الإصلاح الاقتصادي» وتُظهر نجاح برنامج الطروحات الحكومية. لكن النظرة الأعمق ترى أن هذه السياسة تشبه من يبيع أثاث البيت ليسد أقساط الديون؛ تحل أزمة سيولة مؤقتة، لكنها تُقلّص في الوقت ذاته هامش الاستقلال الاقتصادي، وتترك قطاعات حيوية رهينة لمصالح المستثمر الأجنبي.
تقارير دولية عدة أشارت سابقًا إلى أن دفعات الاستثمارات الخليجية، بما فيها الإماراتية، تساعد في سد فجوات عاجلة في ميزان المدفوعات، لكنها لا تمس جوهر الأزمة: ضعف الإنتاجية، عجز الميزان التجاري غير النفطي، هشاشة سوق العمل، واعتماد النمو على مشروعات عقارية وبنية تحتية ضخمة لا تخلق قيمة مضافة كافية على المدى الطويل. صفقة بيع محطة رياح لجهة أجنبية، بدلًا من إشراك مستثمرين في توسعات جديدة أو شراكات إنتاجية، تبدو أقرب إلى إعادة تدوير نفس المنطق: بيع ما تبقّى من أصول لتأجيل الانفجار، لا لمعالجة أسبابه.
في النهاية، ما يجري في جبل الزيت ليس مجرد «استثمار في الطاقة النظيفة»، بل اختبار جديد لسؤال السيادة الاقتصادية: إلى أي حدّ يمكن لدولة أن تواصل بيع أصولها الاستراتيجية تحت ضغط الديون والعجز، قبل أن تجد نفسها «مستأجرة» للبنية التحتية والطاقة على أرضها؟ الحكومة ستحتفل بالمليونات الـ 420، وربما بصفقات أخرى مشابهة، لكن التاريخ سيسأل: كم محطة وميناء وساحل أرضعت خزينة الدولة دولارات مؤقتة، ثم تركت المصريين في الغد أقل سيطرة على مواردهم، وأقل قدرة على تقرير مصير اقتصادهم بأنفسهم؟