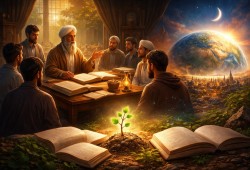طالع ما سبق نشره :
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
بقلم : الشيخ عبد الله علوان
الجزء الثاني
الفصل السادس - مسؤولية التربية الاجتماعية
1-مراعاة الحقوق
تمهيد
المقصود بالتربية الاجتماعية: تأديب الولد منذ نعومة أظفاره على التزام آداب اجتماعية فاضلة، وأصول نفسية نبيلة.. تنبع من العقيدة الإسلامية الخالدة، والشعور الإيماني العميق، ليظهر الولد في المجتمع على خير ما يظهر به من حسن التعامل، والأدب، والاتزان، والعقل الناضج، والتصرف الحكيم...
ولا شك أن هذه المسؤولية من أهم المسؤوليات في إعداد الولد لدى المربين والآباء، بل هي حصيلة كل تربية سبق ذكره سواء أكانت التربية إيمانية أم خلقية أم نفسية.. لكونها الظاهرة السلوكية والوجدانية التي تربي الولد على أداء الحقوق، والتزام الآداب، والرقابة الاجتماعية، والاتزان العقلي، وحسن السياسة والتعامل مع الآخرين.
ومن الثابت تجربة وواقعاً أن سلامة المجتمع، وقوة بنيانه وتماسكه.. مرتبطتان بسلامة أفراده وإعدادهم.. ومن هنا كانت عناية الإسلام بتربية الأولاد اجتماعياً، وسلوكياً.. حتى إذا تربّوا وتكوّنوا وأصبحوا يتقلّبون على مسرح الحياة أعطوا الصورة الصادقة عن الإنسان الانضباطي المّتزن العاقل الحكيم..
فما على المربين إلا أن يشمروا عن ساعد الجد والعزيمة، ليقوموا بمسؤولياتهم الكبرى في التربية الاجتماعية على وجهها الصحيح عسى أن يساهموا في مجتمع إسلامي أفضل تقوم ركائزه على الإيمان، والأخلاق، والتربية الاجتماعية الفاضلة، والقيم الإسلامية الرفيعة.. وما ذلك على الله بعزيز.
وإذا كان لكل تربية وسائل يسيرون عليها، فما هي الوسائل العملية التي تؤدي إلى تربية اجتماعية فاضلة؟
الوسائل – في نظري – تتركز في أمور أربعة:
1- غرس الأصول النفسية النبيلة.
2- مراعاة حقوق الآخرين.
3- التزام الآداب الاجتماعية العامة.
4- المراقبة والنقد الاجتماعي.
غرس الأصول النفسية
أقام الإسلام قواعد التربية الفاضلة في نفوس الأفراد صغاراً وكباراً.. رجالا ونساء.. شيباً وشباناً.. على أصول نفسية نبيلة ثابتة، وقواعد تربوية باقية.. لا يتم تكوين الشخصية الإسلامية إلا بها، ولا تتكامل إلا بتحقيقها، وهي في الوقت نفسه قيم إنسانية خالدة.. ولغرس هذه الأصول النفسية في نفسيات الأفراد والجماعات أصدر الإسلام توجيهاته القيمة.. ووصاياه الرشيدة.. لتتم التربية الاجتماعية على أنبل معنى.. وأكمل غاية.. حتى ينشأ المجتمع على التعاون المثمر، والترابط الوثيق، والأدب الرفيع، والمحبة المتبادلة، والنقد الذاتي البنّاء..
وإليكم أهم هذه الأصول التي يسعى الإسلام لغرسها:
1- التقوى:
هي نتيجة حتمية، وثمرة طبيعية للشعور الإيماني العميق الذي يتصل بمراقبة الله عز وجل والخشية منه، والخوف من غضبه وعقابه، والطمع بعفوه وثوابه.. وهي – كما عرّفها العلماء – أن لا يراك الله حيث نهاك، وأن لا يفقدك حيث أمرك.. أو هي – كما قال البعض: "اتقاء عذاب الله سبحانه بصالح العمل، والخشية من الله تعالى في السر والعلن..".
من هنا كان اهتمام القرآن الكريم بفضيلة التقوى والأمر بها، والحض عليها في كثير من آيات البينات، حتى أن القارئ لا يمر على قراءة صفحة أو صفحات من القرآن الكريم إلا ويجد لفظة التقوى منسابة في الذكر الحكيم هنا وهناك.
ومن هنا كان اهتمام الصحابة الكرام والسلف الصالح بالتقوى، والتحقّق بها، والاجتهاد لها، والسؤال عنها.. فقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أُبيّ ابن كعب عن التقوى، فقال له: (أما سلكت طريقاً ذا شوك، قال: بلى! قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدت، قال: فذلك التقوى).
(فذلك التقوى.. حساسية في الضمير، وشفافية في الشعور، وخشية مستمرة، وحذر دائم، وتوقٍّ لأشواك الطريق.. طريق الحياة.. الذي تتجاذبه أشواك الرغائب والشهوات، وأشواك المطامع والمطامح، وأشواك المخاوف والهواجس، وأشواك الرجاء الكاذب فيمن لا يملك رجاء، والخوف الكاذب ممن لا يملك نفعاً ولا ضرّاً، وعشرات غيرها من الأشواك..)[1].
وتقوى الله – فضلا عن أنها تملأ قلب المؤمن بخشية الله، والمراقبة له – هي منبع الفضائل الاجتماعية كلها، والسبيل الوحيد في اتقاء المفاسد والشرور والآثام والأشواك.. بل هي الوسيلة الأولى التي توجد في الفرد وعيه الكامل لمجتمعه، ولكل من يلتقي معهم من أبناء الحياة.
ولعل في تكرار الرسول صلى الله عليه وسلم قوله "التقوى ههنا" ثلاث مرات – كما سيأتي – ما يؤكد أهمية هذا الأصل النفسي في التربية الاجتماعية، ولا سيما في النهي عن مساس الكرامة، والإضرار بالناس.
وهذه بعض النماذج عن أثر التقوى في سلوك الفرد ومعاملته:
(أ) يروي الغزالي في إحيائه أنه كان عند يونس بن عبيد حُلَل مختلفة الأثمان، منها ضرب قيمة كل حلة منه أربعمائة درهم، وضرب كل حلة مائتان، فمر إلى الصلاة، وخلّف ابن أخيه في الدكان، فجاء أعرابي وطلب حلَّة بأربعمائة فعرض عليه من حلل المائتين، فاستحسنها ورضيها، فاشتراها – أي بأربعمائة درهم – فمشى بها وهي على يديه فاستقبله يونس، فعرف حلّته، فقال للأعرابي: بكم اشتريت؟ فقال: بأربعمائة فقال: لا تساوي أكثر من مائتين فارجع حتى تردها، فقال هذه تساوي في بلدنا خمسمائة وأنا ارتضيها، فقال له يونس: انصرف معي فإن النصح في الدين خير من الدنيا بما فيها. ثم رده إلى الدكان ورد عليه مائتي درهم، وخاصم ابن أخيه في ذلك وقاتله. وقال: أما استحييت؟ أما اتقيت الله؟ ترْبح مثل الثمن وتترك النصح للمسلمين؟ فقال: والله ما أخذها إلا وهو راضٍ بها، قال: فهلا رضيت له ما ترضاه لنفسك!!..
(ب) وقال عبد الله بن دينار: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مكة فعّرسنا في بعض الطريق، فانحدر بنا راعٍ من الجبل، فقال له:
يا راعي، بعني شاة من هذه الغنم. فقال: إني مملوك.
فقال له – اختباراً - : قل لسيدك أكلها الذئب. فقال الراعي: فأين الله؟ فبكى عمر رضي الله عنه ثم غدا مع المملوك، فاشتراه من مولاه وأعتقه، وقال: أعتَقَتْك في الدنيا هذه الكلمة، وأرجو أن تعتقك في الآخرة.
(ج) وكثير من الناس يعرفون قصة الأم مع ابنتها: الأم تريد أن تخلط اللبن طمعاً في زيادة الربح، والبنت تذكرها بمنع أمير المؤمنين.
الأم تقول: أين نحن من أمير المؤمنين؟ إنه لا يرانا.. وترد الابنة بالجواب المفحم: إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا!!..
فعلى فضيلة التقوى والمراقبة لله يجب أن ننشِّئ أبناءنا!!
2- الإخوة:
هي رابطة نفسية تورث الشعور العميق بالعاطفة والمحبة والاحترام.. مع كل من تربطه وإياه من أواصر العقيدة الإسلامية، ووشائج الإيمان والتقوى.. فهذا الشعور الأخوي الصادق يولد في نفس المسلم أصدق العواطف النبيلة في اتخاذ مواقف إيجابية من التعاون، والإيثار، والرحمة، والعفو عند المقدرة.. واتخاذ مواقف سلبية من الابتعاد عن كل ما يضر بالناس في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم والمساس بكراماتهم.. ولقد حث الإسلام على هذه الأخوة في الله، وبيّن مقتضياتها وملتزماتها في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية:
- قال تعالى: {إنما المؤمنون إخوة} الحجرات: 10.
- وقال أيضاً: {سنشُدُّ عَضُدَكَ بأخيك} القصص: 35.
- وقال كذلك: {واذكروا نعمةَ الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً} آل عمران: 103.
- وقال عليه الصلاة والسلام – فيما رواه مسلم – :"المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه ولا يخذله ولا يحقره.. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه. التقوى ههنا (ثلاث مرات)، ويشير إلى صدره...".
- وأخرج البخاري ومسلم: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه..".
- وأخرج مسلم وأحمد: "مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم، وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".
- وروى مسلم في صحيحه: "إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلّي يوم لا ظلّ إلا ظلّي".
وكان من نتيجة هذه الأخوة والمحبة في الله أن تعامل أفراد المجتمع الإسلامي عبر التاريخ، وخلال العصور على أحسن ما تعامل الناس مواساةً وإيثاراً وتعاوناً وتكافلاً..
وإليكم بعض النماذج:
(أ) روى الحاكم في المستدرك أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بعث بثمانين ألف درهم إلى عائشة رضي الله عنها، وكانت صائمة، وعليها ثوب خلَق، فوزعت هذا المال من ساعتها على الفقراء والمساكين.. ولم تُبقِ منه شيئاً، فقالت لها خادمتها: يا أم المؤمنين ما استطعت أن تشتري لنا لحماً بدرهم تفطرين عليه فقالت: يا بنيّة لو ذكرتني لفعلت.
(ب) وروى الطبراني في الكبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ أربعمائة دينار، فجعلها في صرة ثم قال لغلامه: اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح ثم تَشَاغَلْ في البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع، فذهب بها الغلام إليه.. فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك، فقال أبو عبيدة: وصل الله عمر ورحمه، ثم قال: تعاليْ يا جارية، اذهبي بهذه السبعة إلى فلان، وبهذه الخمسة إلى فلان، وبهذه الخمسة إلى فلان.. حتى أنفذها، ورجع الغلام إلى عمر فأخبره، فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل، فقال: اذهب بها إلى معاذ وتشاغل في البيت حتى تنظر ماذا يصنع، فذهب بها إليه، فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في حاجتك، فقال: رحمه الله ووصله، تعاليْ يا جاريه، اذهبي إلى بيت فلان بكذا، اذهبي إلى بيت فلان بكذا.. فاطلعت امرأة هي امرأة معاذ وقالت: نحن والله مساكين فأعطنا، فلم يبق في الخرقة إلا ديناران فرمى بهما إليها، ورجع الغلام إلى عمر فأخبره، فسرّ بذلك فقال: "إنهم إخوة بعضهم من بعض".
(ج) وفي عهد عمر – رضي الله عنه – أصاب الناس قحط وشدة، وكانت قافلة من الشام مكونة من ألف جمل عليها أصناف الطعام واللباس قد حلت لعثمان رضي الله عنه، فتراكض التجار عليه يطلبون أن يبيعهم هذه القافلة، فقال لهم: كم تعطونني ربحاً؟ قالوا خمسة في المائة، قال: إني وجدت من يعطيني أكثر، فقالوا ما نعلم في التجار من يدفع أكثر من هذا الربح؟ فقال لهم عثمان: إني وجدت من يعطيني على الدرهم سبعمائة فأكثر، إني وجدت الله يقول:
{مثلُ الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبّةٍ أنبتت سبعَ سنابل في كُلّ سنبلة مائة حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم} البقرة: 261.
أشهدكم – يا معشر التجار – أن القافلة وما فيها من بُرّ، ودقيق، وزيت، وسمن.. وهبتها لفقراء المدينة، وإنها صدقة على المسلمين.
روى البخاري في الأدب المفرد عن ابن عمر رضي الله عنهما: "لقد أتى علينا زمان وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم".
فعلى خلق الأخوة والمحبة يجب أن ننشّئ أبناءنا!!.
3- الرحمة:
هي رقة في القلب، وحساسية في الضمير، وإرهاف في الشعور.. تستهدف الرأفة بالآخرين، والتألم لهم، والعطف عليهم، وكفكفة دموع أحزانهم وآلامهم.. وهي التي تهيب بالمؤمن أن ينفر من الإيذاء، وينبو عن الجريمة، ويصبح مصدر خير وبر وسلام للناس أجمعين.
ولقد جعل رسول الإسلام صلوات الله وسلامه عليه رحمة الناس بعضهم بعضاً لرحمة الله إياهم، فقد أخرج الترمذي وأبو داود وأحمد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: "الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".
وحَكَمَ صلى الله عليه وسلم على العارين من الرحمة بأنهم هم الأشقياء، فقد روى الترمذي وأبو داود وغيرهما عنه – عليه الصلاة والسلام – أنه قال: "لا تُنْزعُ الرحمة إلا من شقي".
ورحمة المؤمن لا تقتصر على إخوانه المؤمنين، وإنما هو ينبوع يفيض بالرحمة على الناس جميعاً، وقد قال رسول الإسلام صلوات الله وسلامه عليه لأصحابه مرة – فيما رواه الطبراني - :"لن تؤمنوا حتى تَرحموا، قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم، قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة العامة".
بل هي رحمة تتجاوز الإنسان الناطق إلى الحيوان الأعجم..
فالمؤمن وحده هو الذي يرحمه، ويتقي الله فيه، ويعلم أن الله سبحانه سيحاسبه ويسأله إذا قصّر في حقّه أو تسبب في إيذائه، وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة فتحت أبوابها لبغيّ سقت كلبّاً فغفر الله لها، وأن النار فتحت أبوابها لامرأة حبست هرة حتى ماتت، فلا هي أطعمتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض.
ورأى عمر رضي الله عنه رجلا يسحب شاة برجلها ليذبحها فقال له: (ويلك قُدْها إلى الموت قوداً جميلا).
وإليكم بعض النماذج من آثار الرحمة في المجتمع الإسلامي:
(أ) يروي المؤرخون أن عمرو بن العاص في فتح مصر نزلت حمامة بفسطاطه (أي خيمته) فاتخذت من أعلاه عشّاً، وحين أراد عمرو الرحيل رآها، فلم يشأ أن يهيجها بتقويضه الفسطاط، فتركه وتكاثر العمران من حوله، فكانت مدينة "الفسطاط".
(ب) وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان معروفاً في الجاهلية بالشدة والقسوة.. فلما فجَّرَ الإسلام ينابيع الرحمة في قلبه.. كان يرى نفسه مسؤولا أمام الله عن بغلة عثرت بأقصى العراق لأنه لم يعبّد لها الطريق.
(ج) وهذا أبو بكر رضي الله عنه يودّع جيش أسامة بن زيد ويوصيهم قائلا: (لا تقتلوا امرأة ولا شيخاً ولا طفلا، ولا تعقروا نخلا، ولا تقطعوا شجرة مثمرة، وستجدون رجالا فرغّوا أنفسهم في الصوامع، فدعوهم وما أفرغوا أنفسهم له..).
(د) ومن الأمثلة "الوقف الخيري عند المسلمين".
1- وقف الكلاب الضالة حيث توضع في أماكن مخصوصة للرعاية استنفاداً لها من عذاب الجوع، حتى تستريح بالموت أو الاقتناء.
2- وقف الأعراس: حيث يستعير الفقراء من وقف الحلي والزينة في مناسبات الأعراس والأفراح. وبهذا يتيسر للفقير أن يظهر يوم الفرح بحلة رائقة، وبمظهر جميل، فيكتمل شعوره، وينجبر خاطره..
3- وقف مؤنس المرضى والغرباء: وذلك بتعيين من كان رخيم الصوت، حسن الأداء، ليرتلوا الأناشيد الفكاهية، والقصائد الشعرية طول الليل، بحيث يرتل كل منهم ساعة حتى مطلع الفجر سعياً وراء التحفيف عن المريض الذي ليس له من يخفف عنه، وإيناس الغريب الذي ليس له من يؤنسه.
4- وقف الزبادي: فكل خادم كسرت آنيته، وتعرض لغضب مخدومه، له أن يذهب إلى إدارة الوقف، فيترك الإناء المكسور، ويأخذ إناءً جديداً بدلا منه، وبهذا ينجو من الغضب أوالعقاب..
هذا عدا عن وقف إطعام الجائع، وسقاية الظمآن، وكسوة العاري، وإيواء الغريب، ومعالجة المريض، وتعليم الجاهل، ودفن الميت، وكفالة اليتيم، وإغاثة الملهوف، ومواساة العاجز..
ولا شك أن هذه الأوقاف والمبرات ودور العلم وغيرها ما هي إلا أثر من آثار نوازع حب الخير، وعاطفة الرحمة التي أودعها الله في قلوب المؤمنين الرحماء، ونفوس المسلمين الأتقياء.. وهي مفخرة من مفاخر حضارتنا في التاريخ!!..
فعلى هذه المعاني النبيلة من الرحمة يجب أن ننشّئ أبناءنا!!..
4- الإيثار:
وهو شعور نفسي يترتب عليه تفضيل الإنسان غيره على نفسه في الخيرات والمصالح الشخصية النافعة:
والإيثار خلق نبيل إذا قصد به وجه الله تعالى كان من أول الأصول النفسية على صدق الإيمان، وصفاء السريرة، وطهارة النفس.. وهو في الوقت نفسه دعامة كبيرة من دعائم التكافل الاجتماعي، وتحقيق الخير لبني الإنسان.
وحسبنا أن القرآن الكريم سجل للأنصار – وهم جمهور المجتمع الإسلامي فيها – هذه الصور الراقية من صور الإخاء والمواساة والإيثار والنبل والتعاطف.. فقال:
{والذين تبوّؤوا الدارً والإيمان من قبلهم يُحبون من هاجرَ إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجةً مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوقَ شحّ نفسه فأولئك هم المفلحون} الحشر: 09.
هذا الإيثار الطوعي، والتعاطف الاجتماعي الذي تجلى في أخلاق الأنصار لن تجد له مثيلا في تاريخ البشرية، وفي أخبار الأمم..
لقد شارك الأنصار إخوانهم المهاجرين الذين اضطهدوا في دينهم، وأُخرجوا من ديارهم، وأضحوا لا يملكون شيئاً من متاع الحياة وزينتها.. لقد كان الأنصاري يؤاخي المهاجر ويناصره، بل ويؤثره على نفسه في كثير من حظوظ الحياة. وإذا مات أحدهما ورثه الآخر..
وإليكم بعض الصور من مظاهر الإيثار في المجتمع الإسلامي الأول:
(أ) ذكر الغزالي في الإحياء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أهُدي إلى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاة فقال: فلان أحوج إليه مني، فبعث به إليه، فبعث هو أيضاً إلى آخر يراه أحوج منه، فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى رجع إلى الأول بعد أن تداوله سبعة.
(ب) وهذه زينب بنت جحش الأسدية أم المؤمنين التي كانت تلقّب "بأم المساكين" لإيثارها ومواساتها.
فقد روى ابن سعد في طبقاته أن برزة بنت باتع حدثت أنه لما خرج العطاء أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصيبها منه، فلما دخل عليها حامل المال، قالت: غفر الله لعمر! غيري من أخواتي كان أقوى على قسم هذا مني، فقالوا: هذا كله لك، قالت: سبحان الله! واستترت منه بثوب ثم قالت: صبّوه واطرحوا عليه ثوباً.
قالت راوية القصة: ثم قالت لي: أدخلي يدك فاقبضي منه قبضة فاذهبي بها إلى بني فلان، وبني فلان من أهل رَحمها وأيتامها، فقسمت حتى بقيت منه بقية تحت الثوب، فقالت لها برزة بنت باتع: غفر الله لك يا أم المؤمنين، والله لقد كان لنا في هذا حق فقالت: فلكم ما تحت الثوب.. قالت: فكشفنا الثوب فوجدنا خمسة وثمانين درهماً.
وقبل قليل روينا خبر عائشة رضي الله عنها التي وزعت عطاءها الذي بلغ ثمانين ألف درهم على الفقراء والمساكين ولم تُبْقِ لنفسها درهما تفطر عليه، ولو ذكرتها الخادمة لفعلت، فنسيت نفسها في سبيل إسعاد غيرها.
(ج) ومن عجائب الإيثار ما ذكره العدوي – كما روى القرطبي – حين قال: (انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي – ومعي شيء من الماء – وأنا أقول: إن كان به رمق سقيته، فإذا أنا به، فقلت: أسقيك؟ فأشار برأسه أنْ نعم، فإذا برجل يقول: آه... آه! فأشار إليّ ابن عمي أن انطلق إليه، فإذا هو هشام بن العاص، فقلت: أسقيك؟ فأشار أنْ نعم، فسمع أخر يقول: آه... آه! فأشار هشام أن انطلق إليه فإذا هو قد مات، فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات) ولم يشرب أحد الماء لإيثار كل واحد منهم صاحبه.
فعلى هذه المعاني الكريمة من الإيثار والتضحية ونكران الذات يجب أن ننشّئ أبناءنا!!...
5- العفو:
هو شعور نفسي نبيل يترتب عليه التسامح والتنازل عن الحق مهما كان المعتدي ظالماً وجائزاً.. بشرط أن يكون المعتدَى عليه قادراً على الانتقام، وأن لا يكون الاعتداء على كرامة الدين، ومقدسات الإسلام.. وإلاّ.. كان العفو ذلة ومهانة واستسلاماً وخضوعاً.. والعفو بهذا المعنى وبهذه الشروط شيمة خلقية أصيلة تدل على إيمان راسخ، وأدب إسلامي رفيع.. فلا عجب أن نرى القرآن العظيم يأمر به، ويحض عليه في أكثر من آية في كتاب الله عز وجل:
- {وأن تعفو أقربُ للتقوى، ولا تنسوُوا الفضلَ بينكم...} البقرة: 237.
- {ولا تستوي الحسنةُ ولا السيئةُ ادفع بالتي هي أحسنُ فإذا الذي بينك وبينه عداوةٌ كأنه وليٌّ حميم} فصلت: 34.
- {وعبادُ الرحمن الذين يمشونَ على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً} الفرقان: 63.
- {والكاظمين الغيظَ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين} آل عمران: 134.
ومن المعلوم بداهة أن نفسية المؤمن حينما تكون متخلقة بأخلاق الحلم والعفو والتسامح.. فإنه يكون مثلا يُحتذى في الملاطفة وسموّ الخلق، ولين الجانب، وحسن المعشر.. بل يكون كالملَك يمشي على الأرض نُبلاً وطُهراً وصفاء!!...
وإليكم بعض الصور والنماذج في الحلم والعفو والسماحة في سيرة السلف عبر التاريخ:
(أ) قال عبد الله بن طاهر: كنت عند المأمون يوماً، فنادى بالخادم: يا غلام، فلم يجبه أحد، ثم نادى ثانياً وصاح: يا غلام، فدخل غلام تركي وهو يقول: أما ينبغي للغلام أن يأكل ويشرب؟ كلما خرجنا من عندك تصيح: يا غلام، يا غلام، إلى كم يا غلام؟!.. فنكس المأمون رأسه طويلا – فما شككت في أن يأمرني بضرب عنقه – ثم نظر إليّ، فقال: يا عبد الله، إن الرجل إذا حسنتْ أخلاقه، ساءت أخلاق خدمه، وإنا لا نستطيع أن نسيء أخلاقنا لنحسن أخلاق خدمنا..!!.
(ب) ومما يروي أن زين العابدين بن الحسين رضي الله عنهما استدعى غلاماً له، وناداه مرتين فلم يُجبه، فقال له زين العابدين: أما سمعت ندائي؟! فقال: بلى، قد سمعت، قال: فما حملك على ترك إجابتي؟ قال: أمِنْت منك، وعرفت طهارة أخلاقك فتكاسلت، فقال: الحمد لله الذي أمِنَ مني غلامي!..
ومما يروى عنه أيضاً أنه خرج مرة إلى المسجد فسبه رجل، فقصده غلمانه ليضربوه ويؤذونه، فنهاهم زين العابدين، وقال لهم: كفّوا أيديكم عنه، ثم التفت إلى ذلك الرجل وقال: يا هذا، أنا أكثر مما تقول، ومالا تعرفه مني أكثر مما عرفته، فإن كان لك حاجة في ذكره ذكرته لك، فخجل الرجل واستحيا، فخلع زين العابدين قميصه، وأمر له بألف درهم، فمضى الرجل وهو يقول: أشهد أن هذا الشاب ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومما يروى عنه كذلك أن غلامه كان يصب له الماء بإبريق مصنوع من خزف (من طين) فوقع الإبريق على رجل زين العابدين فانكسر، وجرحت رجله، فقال الغلام على الفور – يا سيدي – يقول الله تعالى: {والكاظمين الغيظ}، فقال زين العابدين: لقد كظمت غيظي.. ويقول: {والعافين عن الناس}، فقال: لقد عفوت عنك، ويقول: {والله يحب المحسنين}، فقال زين العابدين: أنت حر لوجه الله!!..
(ج) وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم عُيَيْنَة بن حصين نزل على ابن أخيه الحرّ بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر إذ كان القراء أصحاب مجلس أمير المؤمنين ومشاورته، كهولا كانوا أو شباناً..
فقال عيينة: أستأذن لي على أمير المؤمنين، فاستأذن له فلما دخل قال: هيه يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل (أي الكثير)، ولا تحكم بيننا بالعدل، فغضب عمر حتى همّ أن يوقع به.
فقال الحرّ: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول لنبيه: {خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين}، وإن هذا من الجاهلين، فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقّافاً عند كتاب الله عز وجل[2]!!..
(د) ومما جاء في أسباب النزول أن قريباً لأبي بكر رضي الله عنه اسمه (مسطح) كان يعيش على إحسان أبي بكر وكفالته، لم يتورّع عن الخبط في عرض السيدة عائشة لما شيّع عليها المنافقون ما شيَّعوا في حادثة الإفك، فنسي مسطح بذلك حق الإسلام، وحق القرابة، وحق التكافل.. ومما أثار حفيظة أبي بكر رضي الله عنه، جعله يحلف أن يهجر قريبه هذا، ولا يصله، فنزل قوله تعالى:
{ولا يأتلِ[3] أولوا الفضل منكم والسّعةِ أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا ألا تحبّون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم} النور: 22.
فعفا أبو بكر رضي الله عنه وصفح، وعاد إلى عطائه الأول قائلا: إني أحب أن يغفر الله لي...!
وما هذا الخلق العظيم من العفو والصفح والتسامح والحِلم.. إلا بفضل ما اقتبسوه تأسياً من أخلاق الداعية الأول صلوات الله وسلامه عليه، وبفضل ما امتثلوه من توجيهاته الكريمة عليه الصلاة والسلام.. حتى تسموا أخلاقهم على أخلاق السوقة والعبيد، وتتميز مكارمهم من مكارم الخاصة والعامة..
روى أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من كظم غيظاً وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيّره في أي الحور العين شاء".
وروى الطبراني عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أنبئكم بما يشرف الله بن البنيان، ويرفع الدرجات"؟، قالوا: نعم يا رسول الله، قال: "تحلم على من جهل عليك، وتعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك".
فعلى الراغبين هذه الفضائل من الحلم والتسامح والعفو يجب أن ننشّئ أبناءنا!!
6- الجرأة:
هي قوة نفسية رائعة يستمدها المؤمن من الإيمان بالواحد الأحد الذي يعتقده، ومن الحق الذي يعتنقه، ومن الخلود الذي يوقن به، ومن القدر الذي يستسلم إليه، ومن المسؤولية التي يستشعر بها، ومن التربية التي يُنَشّأ عليها..
وعلى قدر نصيب المؤمن من الإيمان بالله الذي لا يغلب، وبالحق الذي لا يخذل، وبالقدر الذي لا يتحول، وبالمسؤولية التي لا تكل، وبالتربية التي لا تملّ.. بقدر هذا كله يكون نصيبه من قوة الشجاعة والجرأة، وقول كلمة الحق..
ونرى هذا بارزاً في شخصية أبي بكر رضي الله عنه الذي كان أرجح المؤمنين إيماناً بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد تمثّل إيمانه في مواقف جعلت عمر القوي الشديد يقول عنه: (والله لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان هذه الأمة لرجح إيمان أبي بكر..).
موقفه يوم تُوفي الرسول صلوات الله وسلامه عليه فذهل المسلمون، وأخرجتهم الفجيعة عن وعيهم ورشدهم، حتى روي أن عمر قال: من قال إنّ محمداً مات ضربت عنقه بسيفي هذا !. هناك وقف أبو بكر رضي الله عنه يؤذن في الناس بصوت جهير ويقول: "من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت"، وتلا قوله تبارك وتعالى:
{وما محمد إلا رسول قد خَلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين} آل عمران: 144.
وموقفه بعد ذلك، يوم تردّد المسلمون في إنفاذ جيش أسامة الذي جهزه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام قبل مرض موته، فقد طلبوا من أبي بكر أن يوقف مسير هذا الجيش، بسبب أن الغد مليء بالأحداث والاحتمالات، ولا يدري أحد ماذا يفعل العرب في القبائل والقرى إذا علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات.. ولكن أبا بكر أجابهم في حزم عازم، وقال: "والذي نفس أبي بكر يده، لو ظننت أن السباع تحتطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنت أحلّ عقدة عقدها رسول الله بيده، ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته..".
وموقفه رضي الله عنه في حرب المرتدين ومانعي الزكاة في الوقت الذي برزت فيه قرون العصبية الجاهلية كأنها قرون الشياطين.. وكان المسلمون – بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم – كالغنم في الليلة المطيرة، كما وصفتهم السيدة عائشة رضي الله عنها، وحتى لا قال بعض المسلمين لأبي بكر: يا خليفة رسول الله، لا طاقة لك بحرب العرب جميعاً.. الزم بيتك، وأغلق بابك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.. ولكن هذا الرجل الخاشع البكاّء، الرقيق كالنسيم، اللّين كالحرير، الرحيم كقلب الأم ينقلب في لحظات إلى رجل ثائر كالبحر، زائر كالليث، يصيح في وجه عمر: أجبّارٌ في الجاهلية، وخوّار في الإسلام؟ لقد تمّ الوحي واكتمل.. أفينقص الدين وأنا حي؟ والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لأقاتلنهم ما استمسك السيف بيدي، فما كان من عمر رضي الله عنه إلا أن قال: لقد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق[4].
ومن هنا كانت فضيلة الجرأة بالحق من أعظم الجهاد لما روى أبو داود والترمذي وابن ماجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر".
ومن هنا كان الذي يستشهد في سبيل كلمة الحق سيد الشهداء لما روي عن الحاكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله".
ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم يأخذ العهد من أصحابه على أن يقولوا بالحق أينما كانوا.. فقد روى مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: "بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنْشَط والمكْره، وعلى أثَرَةٍ علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم".
ومن هنا كان امتداح الله سبحانه للذين يبلغون رسالات ربهم ولا يخشون أحداً إلا الله، قال تعالى: {الذين يبلِّغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسيباً} الأحزاب: 39.
ولو أردنا أن نتصفح سِفْر رجال الإسلام في التاريخ لرأيناه سفراً حافلا بالأمجاد والبطولات، زاخراً بالجرأة الأدبية في سبيل الحق والإسلام..
وإليكم بعض الأمثلة الحية من مواقفهم البطولية:
(أ) من مواقف العز بن عبد السلام أنه قال مرة لسلطان مصر (نجم الدين أيوب)، وكان في مجلس حافل برجال الدولة: يا أيوب!.. ما حجتك عند الله إذا قال لك: ألم أبوِّئ لك ملك مصر ثم تُبيح الخمور؟ فقال: هل جرى هذا؟ فقال: نعم. الحانة الفلانية يباع فيها الخمور، وتستباح فيها المنكرات، وأنت تتقلب في نعمة هذه المملكة، فقال: هذا أنا ماعملتُه. هذا من زمان أبي، فقال العز بن عبد السلام: أنت من الذين يقولون:
{إنا وجدنا آباءنا على أمة[5] وإنا على آثارهم مقتدون} الزخرف: 13.
فرسم السلطان بإبطال تلك الحانة وإغلاقها..
(ب) كان سلمة بن دينار المكنىّ بأبي حازم يدخل على معاوية، فيقول: السلام عليك أيها الأجير، فإذا حاولوا أن يقولوا لأبي حازم قل: السلام عليك أيها الأمير، أبى عليهم ذلك، ثم التفت إلى معاوية فقال له: (إنما أنت أجير هذه الأمة، أستأجرك ربك لرعايتها).
(ج) وإليكم هذه المحاورة التي جرت بينه وبين سليمان بن عبد الملك:
قال سليمان: يا أبا حازم مالنا نكره الموت؟. قال: لأنكم خربتم آخرتكم، وعمرتم الدنيا، فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب.
قال سليمان: فكيف القدوم غداً على الله؟. قال: أما المحسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما المسيء فكالعبد الآبق يقدم على مولاه.
قال سليمان: أي القول أعدل؟. فقال: قول الحق عند من تخافه أو ترجوه.
قال سليمان: فأي المؤمنين أكْيَس؟ (أي أعقل)؟. قال: رجل عمل بطاعة الله، ودلّ الناس عليها.
قال سليمان: فأيّ المؤمنين أحمق؟. قال: رجل انحطّ في هوى أخيه وهو ظالم، فباع آخرته بدنيا غيره.
قال سليمان: هل لك يا أبا حازم أن تصحبنا؟ فتصيب منا، ونصيب منك. قال: أعوذ بالله!..
قال سليمان: ولِمَ ذاك؟. قال: أخشى أن أركن إليكم قليلا، فيذيقني الله ضعف الحياة، وضعف الممات.
قال له سليمان وقد قام ليذهب: أوصنى يا أبا حازم.. فقال: سأوصيك وأوجز: عظّم ربك، ونزّهه أن يراك حيث نهاك، أو يفقدك حيث أمرك)!!..
فعلى هذه الفضيلة من الثبات والجرأة في الحق يجب أن ننشّئ أولادنا!!..
تلكم هي أهم الأصول النفسية التي يسعى الإسلام جهده إلى غرسها في نفس المؤمن، وكلها تتضافر في تكوين الشخصية المسلمة، وكلها تشير إلى أن الإسلام في تحقيق التربية الاجتماعية لدى الأفراد يجب أن يبدأ من نقطة بناء الفرد بناء صحيحاً، وأن أي تربية أو تكوين لا يقوم على هذه الأصول النفسية التي وضع قواعدها الإسلام فإن التربية تكون فاشلة وأن ارتباط الفرد بالمجتمع يكون أوهن من بيت العنكبوت.
لذا وجب على الآباء والمربين جميعاً وعلى الأمهات بشكل خاص:
أن يرسِّخوا في نفوس أطفالهم عقيدة الإيمان والتقوى، وفضيلة الأخوة والمحبة، ومعاني الرحمة والإيثار والحلم.. وخلق الإقدام والجرأة في الحق.. وغيرها من الأصول النفسية النبيلة.. حتى إذا شبّ الأولاد عن الطوق، وبلغوا السنّ التي تؤهلهم أن يخوضوا خضم الحياة.. أدوا ما عليهم من واجبات ومسؤوليات دون تواكل أو تردد أو قنوط.. ثم بالتالي قاموا بكل الالتزامات نحو الآخرين دون إهمال لحق أو تقصير في الواجب.. بل كانت معاملاتهم وآدابهم وأخلاقهم الاجتماعية على أحسن ما رأى الناس، وأسمى مما يتصوره الخيال.
وأي نظام في التربية لا يقوم على هذه الأصول النفسية، والأسس التربوية، يكون كمن رأى شجرة بدأ يدب فيها الاصفرار والذبول فأخذ يعالجها من أوراقها، ولم يلتفت إلى إصلاح الجذر الذي إذا صلح صلحت الشجرة كلها..
وبعبارة أوضح أن الذي يقوم بمسؤولية التربية الاجتماعية إذا لم يَبْنِ تربيته على هذه الأصول الثابتة كان كمن يرقم على ماء، وينفخ في رماد، ويصرخ في واد دون فائدة أو جدوى..
[1] من كتاب الظلال لسيد قطب رحمه الله ج 1 ص 40.
[2] رواه البخاري.
[3] ولا يأتل: ولا يحلف.
[4] من كتاب (الإيمان والحياة) للأستاذ يوسف القرضاوي ص 274 مع شيء من التصرف.
[5] أمة: طريقة ودين.
مراعاة حقوق الآخرين - حق الأبوين
سبق أن ذكرنا في مبحث "غرس الأصول النفسية النبيلة" أن الإسلام أقام قواعد التربية الفاضلة على أصول نفسية تتصل بالعقيدة، وترتبط بالتقوى.. لتتم التربية الاجتماعية لدى الفرد على أنبل معنى، وأكمل غاية.. حتى ينشأ المجتمع على التعاون المثمر، والترابط الوثيق، والأدب العالي، والمحبة المتبادلة، والنقد الذاتي البنّاء..
وكنا ألمحنا إلى أن من أميز الأصول التي يجب أن يقوم التعامل الاجتماعي على أساسها هي: عقيدة الإيمان والتقوى، وفضيلة الأخوة والمحبة، ومبادئ الرحمة والإيثار والحلم.. وخُلق الإقدام والجرأة في الحق..
وكنا أكدنا أن المربين جميعاً إذا لم يرسخوا هذه الأصول النفسية في نفوس أطفالهم منذ الصغر.. فإنهم – ولا شك – سيسيرون في المجتمع في طريق الشذوذ والانحراف.. بل يكونون أداة هدم وإجرام وتخريب لكيان المجتمع وتماسكه.. وإذا شبّوا على هذا الفساد والانحراف.. لا ينفع معهم توجيه ولا تربية ولا إصلاح!!..
فالذي نخلص إليه بعد هذه التقدمة أن مراعاة حقوق المجتمع متلازمة كل التلازم مع الأصول النفسية النبيلة، بل بعبارة أوضح أن الأصول النفسية معنى، وأن مراعاة حقوق المجتمع مظهر، وإن شئت فقل: الأولى روح، والثانية جسم، فلا يمكن استغناء الأولى عن الثانية بحال.. وإلا كان الخلل والفوضى والاضطراب..
ولكن ما هي أهم هذه الحقوق الاجتماعية التي يجب أن نرشد الولد إليها، وننشئه عليها، ونأمره بها.. حتى يعتاد عليها ويقوم بأدائها خير قيام؟..
أهم هذه الحقوق هي:
1- حق الأبوين.
2- حق الأرحام.
3- حق المعلم.
4- حق الرفيق.
5- حق الكبير.
ولنتكلم عن كل حق من هذه الحقوق بشيء من التفصيل، ليقوم المربي على غرسها وترسيخها في الولد منذ نشأته وعلى الله التكلان، وهو المستعان:
1- حق الأبوين:
إن من أهم ما يجب أن يحرص المربي عليه تعريف الولد بحق والديه عليه، وذلك ببرّهما وطاعتهما والإحسان إليهما والقيام بخدمتهما، ورعاية شيخوختهما، وعدم رفع الصوت فوق صوتهما، والدعاء لهما بعد مماتهما.. إلى غير ذلك من هذه الحقوق الواجبة، والآداب الأبوية اللازمة..
وهذه طائفة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في برّ الوالدين، فعلى الآباء والمربين أن يعلّموها أولادهم منذ الصغر حتى يأخذوا بها، ويعملوا على إرشاداتها.
(أ) رضى الله في رضاهما: روى البخاري (في الأدب المفرد) عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: "ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسباً إلا فتح الله له بابين – يعني من الجنة – وإن كان واحداً فواحد، وإن غضب أحدهما لم يرض الله عنه حتى يرضى عنه، قيل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه".
- وجاء في سبُل السلام – عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "رضى الله في رضى الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين".
(ب) برهما مقدم على الجهاد في سبيل الله: روى البخاري عن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أجاهد، قال: "لك أبوان"؟ قال نعم، قال: ففيهما فجاهد.
- وروى أحمد والنسائي عن معاوية بن جاهمة السلمي أن جاهمة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أردت الغزو وجئت أستشيرك، فقال: "هل لك من أم"؟ قال نعم، قال: "الزمها فإن الجنة عند رجليها".
- وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما – قال: أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله، قال: "فهل من والديك أحد حيّ"؟ قال: بل كلاهما قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال نعم، قال: "فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما".
(ج) من البر الدعاء لهما بعد مماتهما وإكرام صديقهما: امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى: {واخفضْ لهما جناح الذّل من الرحمة وقل ربّ ارحمهما كما ربياني صغيراً} الإسراء: 24.
- وروى البخاري في (الأدب المفرد) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "ترفع للميت بعد موته درجته فيقول: أيّ ربيّ أي شيء هذا؟ فيقول له: ولدك استغفر لك".
- وروى أبو داود وابن ماجة والحاكم عن مالك بن ربيعة قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة، فقال: يا رسول الله هل بقي علي من برّ أبوي شيء أبرّهما به بعد وفاتهما؟ قال: نعم، "الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما".
هذا عبد الله بن عمر بن الخطاب – رضي الله عنهما – يضرب لنا المثل الصالح في الولد الصالح البار، ويروي لنا عبد الله بن دينار ذلك فيقول: - كما روى مسلم في صحيحه – أن عبد الله بن عمر لقيه رجل بطريق مكة فسلم عليه عبد الله، وحمله على حمار كان يركبه، وأعطاه عمامة كانت على رأسه، قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله إنهم الأعراب، وإنهم يرضون باليسير، فقال عبد الله: إن أبا هذا كان ودّاً لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أبرّ البر صلة الرجل أهل ودّ أبيه".
- وجاء في (مجمع الزوائد) عن أنس – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من البر أن تصل صديق أبيك".
(د) تقديم الأم بالبرّ على الأب: لما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق بحسن صحابتي؟ قال: "أمك. قال ثم مَنْ؟ قال: أمك. قال: ثم مَنْ، قال: أمك. قال ثم مَنْ؟ قال: أبوك".
- وروى ابن كثير في تفسيره عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا كان في الطواف حاملاً أمه يطوف بها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أديت حقها؟ قال: "لا، ولا بزفرة[1] واحدة".
وجاء في (مجمع الزوائد) عن بريدة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني حملتُ أمي على عنقي فرسخين في رمضاء شديدة لو ألقيت فيها بضعة لحم لنضجت فهل أديت شكرها؟ فقال: "لعله أن يكون لطلقة واحدة".
والإسلام قدم الأم بالبر على الأب لسببين:
الأول: أن الأم تعاني بحمل الولد وولادته وإرضاعه والقيام على أمره وتربيته أكثر مما يعانيه الأب، وجاء ذلك صريحاً في قوله تبارك وتعالى:
{ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمّه وهْناً على وهنٍ وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إليَّ المصير} لقمان: 14.
وقبل قليل سمعنا قول الرجل الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم إني حملت أمي على عنقي.. فهل أديت شكرها؟ وسمعنا – جوابه عليه الصلاة والسلام - :"لعله أن يكون لطلقة واحدة".
ومن طرائف ما يذكر في هذا أن رجلا سمع أعرابيا حاملا أمه في الطواف وهو يقول:
إني لها مطية لا أذعر[2]
إذا الركاب[3] نفرت لا أنفر
ما حملَتْ وأرضعتني أكثرُ
الله ربي ذو الجلال أكبرُ
ثم التفت إلى ابن عباس وقال: أتراني قضيت حقّها؟
قال: لا والله ولا طلقة من طلقاتها.
الثاني: أن الأم – بما جُبلت عليه من عاطفة وحب وحنان – أكثر رحمة وعناية واهتماماً من الأب .. فالولد قد يتساهل في حق أمه عليه لما يرى من ظواهر عطفها ورحمتها وحنانها.. لهذا جاءت الشريعة الغراء موصية الولد بأن يكون أكثر برّاً بها، وطاعة لها.. حتى لا يتساهل في حقها، ولا يتغاضى عن برها واحترامها وإكرامها..
وما يؤكد حنان الأم وشفقتها أن الولد مهما كان عاقّاً لها، مستهزئاً بها، معرضاً عنها.. فإنها تنسى كل شيء حين يصاب بمصيبة، أو تحل عليه كارثة..
ذكر أبو الليث السمرقندي عن أنس – رضي الله عنه - :"أن شابّاً كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسمى علقمة، فمرض واشتد مرضه، فقيل له: قل لا إله إلا الله فلم ينطق لسانه، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: فقال: هل له أبوان؟ فقيل: أما أبوه فقد مات، وله أم كبيرة، فأرسل إليها، فجاءت، فسألها عن حاله فقالت: يا رسول الله كان يصلي كذا وكذا، وكان يصوم كذا وكذا، وكان يتصدق بجملة دراهم ما ندري ما وزنها وما عددها؟ قال: فما حالك وحاله؟ قالت: يا رسول الله أنا عليه ساخطة واجدَة، قال لها: ولمَ ذلك؟ قالت: كان يؤثر عليّ امرأته ويطيعها في الأشياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سخط أمه حجب لسانه عن شهادة أن لا إله إلا الله".
ثم قال: يا بلال، انطلق واجمع حطباً كثيراً حتى أحرقه بالنار، فقالت يا رسول الله! ابني وثمرة فؤادي تحرقه بالنار، بين يدي؟! وكيف يحتمل قلبي ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسرّك أن يغفر الله له فارضي عنه؟ فوالذي نفسي بيده لا ينتفع بصلاته ولا بصدقته ما دمتِ ساخطة، فرفعت يدها وقالت: أُشهِد الله تعالى في سمائه، وأنت يا رسول الله ومن حضر أني قد رضيت عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، انطلق فانظر هل يستطيع علقمة أن يقول: لا إله إلا الله فلعل أمه قد تكلمت بما ليس في قلبها حياء من رسول الله، فانطلق بلال، فلما انتهى إلى الباب سمعه يقول: لا إله إلا الله ومات من يومه وغُسّل وكفن، وصلّى النبي عليه الصلاة والسلام عليه، ثم قام على شفير القبر، وقال: يا معشر المهاجرين والأنصار من فَضَّل زوجته على أمه فعليه لعنة الله، ولا يقبل منه صرف[4]
ولا عَدل[5]" وروى الحديث بلفظ آخر الطبراني وأحمد.. لهذين السببين كان بر الأم مقدماً على بر الأب..
ألا فليعلم المربون هذا، ليقوموا بمهمتهم الكبرى في تلقين الولد حقيقة البر، والعطف على الأم، والعناية بها، والقيام بحقها!!..
(هـ) آداب البر بالأبوين: على المربين أن يلقنوا الأولاد هذه الآداب السلوكية مع آبائهم وأمهاتهم وهي مرتبة كما يلي: ألا يمشوا أمامهم، وألا ينادوهم بأسمائهم، وألا يجلسوا قبلهم، وألا يتضجروا من نصائحهم، وألا يأكلوا من طعام ينظرون إليه، وألا يَرقُوا مكاناً عالياً فوقهم، وألا يخالفوا أمرهم..
والأصل في مراعاة هذه الآداب قوله تبارك وتعالى:
{وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفٍّ[6] ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً، واخفض لهما جناح الذلّ من الرحمة وقل ربّ ارحمهما كما ربياني صغيراً} الإسراء: 23-24.
وقوله عليه الصلاة والسلام:
- "ما برّ أباه من سدّد إليه الطرق بالغضب" (مجمع الزوائد ج: 8).
- عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ومعه شيخ فقال له: يا هذا! من هذا الذي معك؟ قال: أبي، قال: فلا تمش أمامه، ولا تجلس قبله، وتَدْعُهُ باسمه، ولا تستسب له (مجمع الزوائد ج: 8).
وهذه طائفة من أخبار السلف في التزام هذه الآداب مع آبائهم:
• ذكر صاحب عيون الأخبار هذا الخبر: قيل لعمر بن زيد: كيف برّ ابنك بك؟ قال: ما مشيت نهاراً قط إلاّ وهو خلفي، ولا ليلا إلاّ مشى أمامي، ولا رقى سطحاً وأنا تحته.
• وذكر صاحب (مجمع الزوائد) هذه القصة: عن أبي غسان الضبيّ قال: خرجت أمشي مع أبي بظهر الحرة، فلقيني أبو هريرة فقال: من هذا؟ قلت: أبي، قال: لا تمش بين يدي أبيك ولكن امش خلفه أو إلى جانبه، ولا تدع أحداً يحول بينك وبينه، ولا تمش فوق أجّار (سطح) أبيك. ولا تأكل عَرْقاً [7] قد نظر أبوك إليه لعلّه اشتهاه.
• ومما جاء في (عيون الأخبار): قال المأمون رحمه الله: لم أر أحداً أبرّ نم الفضل بن يحيى بأبيه، بلغ من بره أن يحيى كان لا يتوضأ إلا بماء مسخن، وهما في السجن، فمنعهما السجان من إدخال الحطب في ليلة باردة. فقام الفضل – حيث أخذ أبوه يحيى مضجعه – إلى قمقم كان يسخن فيه الماء، فملأه ثم أدناه من نار المصباح، فلم يزل قائماً وهو في يده حتى أصبح. فعل كل هذا برّاً بأبيه ليتوضأ بالماء الساخن.
• وحضر صالح العباسي مجلس المنصور مرة، وكان يحدثه، ويكثر من قوله: (أبي رحمه الله)، فقال له حاجبه الربيع: لا تكثر من الترحم على أبيك بحضرة أمير المؤمنين، فقال: لا ألومك فإنك لم تذق حلاوة الآباء، فتبسم المنصور وقال: هذا جزاء من تعرض لبني هاشم.
• وروى ابن حبان في صحيحه: أن رجلا أتى أبا الدرداء، فقال: إن أبي لم يزل بي حتى زوّجني، وإنه الآن يأمرني بطلاقها؟ قال: ما أنا الذي آمرك أن تَعُقّ والديك، ولا بالذي آمرك أن تطلّق امرأتك غير أنك إن شئت حدثتك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: "الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ على ذلك الباب إن شئت أو دَعْ"[8]. قال: فأحسب عطاء قال: فطلّقها.
وفي رواية ابن ماجة والترمذي أن رجلا أتى أبا الدرداء فقال: ان لي امرأة، وإن أمي تأمرني بطلاقها؟، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضعْ هذا الباب أو احفظه.
• وروى ابن ماجة وابن حبان في صحيحه عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: كان تحتي امرأة أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها فأبيت، فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طلقها".
(و) التحذير من العقوق: العقوق معناه العصيان والمخالفة وعدم أداء الحقوق.. فمن العقوق أن ينظر الولد إلى أبيه نظرة شزر عند الغضب، ومن العقوق أن يعتبر الولد نفسه مساوياً لأبيه.
ومن العقوق أن يتعاظم الولد عن تقبيل يديْ والديه، أو لا ينهض لهما احتراماً وإجلالاً.
ومن العقوق أن يستحوذ الغرور على الولد فيستحي أن يعُرّف بأبيه لا سيما إذا كان الولد في مركز اجتماعي مرموق.
ومن العقوق ألا يقوم الولد بحق النفقة على أبويه الفقيرين فيضطرهما إلى إقامة الدعوى عليه ليلزمه القاضي بالإنفاق عليهما.
ومن أكبر العقوق أن يتأفف الولد من أبويه ويتضجر منهما ويعلو صوته عليهما، ويقرّعهما بكلمات مؤذية جارحة، ويجلب الإهانة لهما، والمسبة لشخصهما.
فلا عجب أن يحذّر عليه الصلاة والسلام من العقوق، وأن يبين ما للعاق من الإثم والوزر وحبوط العمل، والانتقام في العاجلة والآجلة:
- روى البخاري ومسلم عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر (ثلاثاً)؟ قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئاً فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور.. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت (رحمة به وإشفاقاً عليه)".
- وروى أحمد والنسائي والبزار والحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة حرّم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة: "مُدمن الخمر، والعاق لوالديه، والدّيوث الذي يُقّر الخبث في أهله".
- وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من الكبائر شتم الرجل والديه، قال: يا رسول الله! وهل يشتم الرجل والديه! قال: نعم يسبّ أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه".
- وروى أحمد وغيره عن معاذ بن جبل – رضي الله عنه – قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات، قال: "لا تشرك بالله شيئاً وإن قتلت وحرّقت، ولا تعُقّنّ والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك...".
- وروى الحاكم والأصبهاني عن أبي بكرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل الذنوب يؤخر الله ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإن الله يعجّله لصاحبه في الحياة قبل الممات".
- وسبق أن ذكرنا حديث علقمة في بحث (تقديم الأم على الأب في البر) فارجع إليه لترى نتيجة من يعق والديه.
- وروى الأصبهاني وغيره عن أبي العباس الأصم عن العوّام بن حوشب رضي الله عنه قال: نزلت مرة حيّاً، وإلى جانب ذلك الحي مقبرة، فلما كان بعد العصر انشق منها قبر فخرج رجل رأسه رأس حمار، وجسده جسد إنسان، فنهق ثلاث نهقات، ثم انطبق عليه القبر، فإذا عجوز تغزل شعراً أو صوفاً، فقالت امرأة: ترى تلك العجوز؟ قلت: مالها؟ قالت: تلك أم هذا، قلت: وما كانت قصته؟ قالت: كان يشرب الخمر فإذا راح تقول له أمه: يا بنيّ اتق الله إلى متى تشرب هذه الخمر، فيقول لها: إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار، قالت: فمات بعد العصر، قالت: فهو ينشق عنه القبر بعد العصر كل يوم، فينهق ثلاث نهقات ثم ينطبق عليه القبر.
هذه هي أهم الأسس التي يجب على المربي أن ينشّئ ولده عليها، ويلقنه إياها حتى يتدرج الولد على البر، ويفهم منذ نعومة أظفاره حق الأبوين..
وإذا كان الولد منذ الصغر يقوم بهذا الحق على الوجه الصحيح الذي يريده الإسلام، فإن قيامه بالحقوق الأخرى من أرحام وجيران ومعلمين.. يكون أرغب وآكد.. لأن فضيلة بر الوالدين هي منبع الفضائل الاجتماعية جميعاً، فمن السهل على الولد الذي تَربّى على البر واحترام الأبوين.. أن يتربى على احترام الجار، واحترام الكبير، واحترام المعلّم، واحترام الناس جميعاً..
لهذا كله – كان تركيزي في البحث على الوالدين أكثر من أي حق من الحقوق الاجتماعية التي سيأتي التفصيل عنها.. ذلك لأن فضيلة البر بالأبوين هي أُسّ الفضائل جميعاً، بل هي منطلق لكل حق في هذا الوجود!!...
فاستنتاجاً مما ذُكر بين يدي المربي أهم التوجيهات التي يجب أن يلقن عليها الولد:
1- إطاعة الأم والأب في كل ما يأمران به الولد إلا المعصية.
2- مخاطبتهما بلطف وأدب.
3- النهوض لهما إذا دخلا عليه.
4- تقبيل يديهما صباحاً ومساء وفي المناسبات.
5- المحافظة على سمعتهما وشرفهما ومالهما.
6- إكرامهما وإعطاؤهما كل ما يطلبان.
7- مشاورتهما في كل الأعمال والأمور.
8- الإكثار من الدعاءس والاستغفار لهما.
9- إذا كان عندهما ضيف فالجلوس بقرب الباب، ومراقبة نظراتهما لعلهما يأمران بشيء خِفْية.
10- العمل على ما يسرهما من غير أن يأمرا الولد به.
11- عدم رفع الصوت عالياً أمامهما.
12- عدم مقاطعتهما أثناء الكلام.
13- عدم الخروج من الدار إذا لم يأذنا.
14- عدم ازعاجهما إذا كانا نائمين.
15- عدم تفضيل الزوجة والولد عليهما.
16- عدم لومهما إذا عملا عملاً لا يعجبك.
17- عدم الضحك بحضرتهما إذا لم يكن ثمّة موجب للضحك.
18- عدم تناول الطعام مما يليهما.
19- عدم مد اليد إلى الطعام قبلهما.
20- عدم النوم والاضطجاع وهما جالسان إلا إذا أذنا بذلك.
21- عدم مد الرجلين أمامهما.
22- عدم الدخول قبلهما، أو المشي أمامهما.
23- تلبية ندائهما بسرعة في حال ندائهما.
24- إكرام أصحابهما في حياتهما وبعد موتهما.
25- عدم مصاحبة إنسان غير بارّ بوالديه.
الدعاء لهما ولا سيما بعد الموت فإنهما ينتفعان به، والإكثار من قوله تعالى: {رب ارحمهما كما ربياني صغيراً} الإسراء: 24.
[1] يقصد التوجع الذي تلاقيه الأم أثناء الحمل والولادة.
[2] لا أذعر: لا أفزع.
[3] الركاب: الإبل.
[4] الصرف: التوبة.
[5] العدل: الفدية.
[6] أفّ: كلمة تضجر وتأفف.
[7] العَرق: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم.
[8] دع: أي اترك وتجنب.
مراعاة حقوق الآخرين - حق الأرحام
الأرحام هم من ترتبط بهم – أيها الإنسان – بصلة القرابة والنسب، وهم على الترتيب التالي: الآباء والأمهات، والأجداد الجدات، والإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، وأولاد الأخ، وأولاد الأخت، والأخوال والخالات، ثم من يليهم من الأقرباء، الأقرب فالأقرب..
وهؤلاء سمّوا في الشرع أرحاماً لسببين:
الأول: لاشتقاق الرحم من اسم الرحمن، وهذا ما أكده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الله عز وجل: (أنا الله، وأنا الرحمن.. خلقت الرحم، وشققت لهما اسماً من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعتُه).
ولا يخفى ما في الاشتقاق من باعث إلى الرحمة، ومن دافع إلى العطف والحنان نحو من له حق الصلة من ذوي القرابة والنسب.
الثاني: لانحدار القرابة من الأصل الذي ينتمي إليه الإنسان، وهذا ما عناه النبي صلى الله عليه وسلم في توجيهاته الكريمة في وجوب الصلة، والتحذير من القطيعة..
وهذا – لا شك – مما يحرك عاطفة القرابة من أعماقها، ويثير في الحنايا مشاعر أخوية ما أسماها!!..
فما على المربين إذن – بعد تبيان هذه الحقائق – إلا أن يشمروا عن ساعد الجد والعمل، ليُبَصِّروا الولد منذ سن الوعي والتمييز بحقوق القرابة والرحم.. لتنمو في نفسية الولد نزعة التطلع إلى الاجتماع بالآخرين، وتتأصل في ذاتيته محبة من تربطه وإياهم رابطة النسب.. حتى إذا بلغ الولد سن الرشد والنُّضج العقلي قام بواجب العطف والإحسان لهم، واحترم كبيرهم، ورحم صغيرهم، كفكف دموع الحزن عن مصابهم، ومدّ يد العون والإحسان إلى مكروبهم وفقيرهم.. وهذا لا يتأتى إلا بتأديب الولد على هذه الخصال، وتعويده على هاتيك الفضائل والمكارم.
فلا عجب حين نتلو كتاب الله عز وجل أن نمرّ على الآيات التي تحض على صلة الرحم، وتأمر بالإحسان إلى ذوي القربى..
وإليكم – أيها المربون – طاقة من هذه الآيات:
- {واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً} النساء: 07.
- {وآتِ ذا القربى حقَّهُ والمسكين وابن السبيل ولا تبذّر تبيذيراً} الإسراء: 26.
- {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى...} النساء: 36.
وبالمقابل.. القرآن الكريم يحذر من قطيعة الرحم، ويعتبر هذه القطيعة بغياً وإفساداً في الأرض يستحق صاحبها اللعنة وسوء الدار، قال تعالى:
- {والذين ينقضون عهدَ الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار} الرعد: 25.
- وقال أيضاً: {فهل عسيتم إن توليتم أن تُفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم اله فأصمّهم وأعمى أبصارهم} محمد: 22-23.
فإذا كانت هذه نهاية ومصير من يقف من رحِمِه هذا الموقف الظالم المعادي.. فما على المربين إلا أن يُبيِّنوا لمن كان لهم عليهم حق التربية مغبة القطيعة، وما يترتب عليها من نتائج وخيمة لا تحمد عقباها، كما عليهم أن يبصروهم بالثمرات التي يجنونها من صلتهم للرحم، وقيامهم بحق القرابة..
وإليكم – أيها المربون – أفضل الثمرات في صلة الرحم، أرشد إليها المربِّي الأول صلوات الله وسلامه عليه عسى أن تُعلموها أولادكم، وتلقنوها لمن كان له حق التربية عليكم.
• صلة الرحم شعار الإيمان بالله واليوم الآخر لما روى الشيخان عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رَحِمَه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت".
• صلة الرحم تزيد في العمر، وتوسع في الرزق لما روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أحبّ أن يبسط له في رزقه ويُنْسَأ له في أثره (يزاد في عمره) فليصل رحمه".
• صلة الرحم تدفع عن الواصل ميتة السوء لما روى أبو يعلى عن أنس – رضي الله عنه – عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يقول: "إن الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بهما في العمر، ويدفع بهما ميتة المكروه والمحذور".
• صلة الرحم تعمر الديار وتثمر الأموال لما روى الطبراني والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله ليعمّر بالقوم الديار، ويثمّر لهم الأموال، وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضاً لهم، قيل: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: بصلتهم الرحم".
• صلة الرحم تغفر الذنب وتكفّر الخطايا لما روى ابن حبان والحاكم عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: "أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: إني أذنبت ذنباً عظيماً فهل لي من توبة؟ فقال: هل لك من أم؟ قال: لا، قال: فهل لك من خالة؟ قال: نعم، قال: فبرِّها".
• صلة الرحم تيُسر سبيل الحساب وتدخل صاحبها الجنة لما روى البزار والطبراني والحاكم عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من كنّ فيه حاسبه الله حساباً يسيراً وأدخله الجنة برحمته، قالوا: وما هي يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ قال: تعطي من حرمك، وتصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، فإذا فعلت ذلك يدخلك الله الجنة".
وروى الشيخان عن جبير بن مطعم – رضي الله عنه - ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يدخل الجنة قاطع رحم".
• صلة الرحم ترفع الواصل إلى الدرجات العلى يوم القيامة لما روى البزار والطبراني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: تحلُم على من جهل عليك، وتعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك".
فحينما يضع المربي بين يدي الولد هذه الفضائل التي يحظى بها مِنْ رحمه.. فلا شك أن الولد يندفع بكليته إلى محبة أقربائه، وصلة أرحامه، فيعرف لهم فضلهم، ويؤدي إليهم حقهم، ويشاركهم في آلامهم وأفراحهم، ويفرّج عن مكروبهم وفقيرهم.. وهذا لعمري غاية البر، ومنتهى الصلة... فما أحوجنا إلى مربين يعلّمون الأولاد هذه الحقائق، ويرشدونهم إلى هاتيك المكارم والخصال!!..
مراعاة حقوق الآخرين - حق الجار
ومن الحقوق التي يجب أن يهتم المربون لها، ويعتنوا بها حق الجار.. ولكن من هو الجار؟ هو كل مجاور لك عن اليمين والشمال، والفوق والتحت.. إلى أربعين داراً.. فكل هؤلاء جيرانك، لهم عليك حقوق، وعليهم لك واجبات.. وهذا المعنى للجوار مستفاد من الحديث الذي رواه الطبراني عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله إني نزلت في محلّة بني فلان، وإن أشدهم إليّ أذى أقربهم لي جواراً، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعليّاً – رضي الله عنهم – يأتون المسجد، فيقومون على بابه، فيصيحون: ألا إن أربعين داراً جار، ولا يدخل الجنة من خاف جاره بوائقه (شروره).
وحقوق الجار – في نظر الإسلام – ترجع إلى أربعة أصول: هي ألا يُلْحِق الرجل بجاره أذى، وأن يحميه ممن يريده بسوء، وأن يعامله بإحسان، وأن يقابل جفاءه بالحلم والصفح..
(أ) كف الأذى عن الجار:
والأذى أنواع منها: الزنى، والسرقة، والسباب، والشتائم، ورمي الأوساخ.. وأخطرها الزنى، والسرقة، وانتهاك الحرمة، وهذا مما أكده رسول الإسلام – صلوات الله وسلامه عليه – لما كان يوجه أصحابه إلى أكرم الخصال وينهاهم عن أقبح الفعال.. روى الإمام أحمد والطبراني عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: "ما تقولون في الزنى؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره، قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامة، قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره".
أما أذى اليد وأذى اللسان فيدخل في مضمون قوله عليه الصلاة والسلام: "والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: مَنْ يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه (شروره)" رواه الشيخان.
ويروى عن عبد الملك بن مروان قال: لمؤدّب ولده: إذا روّيتهم شعراً فلا تروّهم إلا مثل قول (العُجيَر السلولي):
يبين الجار حين يبين عني
ولم تأنس إليّ كلاب جاري
وتظعن جارتي من جنب بيتي
ولم تستر بستر من جدار
وتأمن أن أطالع حين آتي
عليها وهي واضعة الخمار
كذلك هدي آبائي قديماً
توارثه النجار عن النجار
ويشبه قول حاتم الطائي في الحفاظ على عرض الجار:
إذا ما بتّ أختل[1] عرس جاري
ليُخْفِيني الظلام فما خفيتُ
أأفضح جارتي وأخون جاري
فلا والله أفعل ما حييتُ
وكذلك قول عنترة:
وأغض طرفي إن بدت لي جارتي
حتى يُواري جارتي مأواها
ومما يؤدي الجار: النظر إليه بعين الاحتقار، مثلما يفعل من لم يتربوا تربية فاضلة إذ يزرون جارهم الفقير، ويحتقرون ابن حيّهم المسكين، قال حسان بن ثابت رضي الله عنه:
فما أحد منا بمُهْدٍ لجاره
أذاة ولا مُزْرٍ به وهو عائد
لأنا نرى حقَّ الجوار أمانة
ويحفظه منا الكريم المعاهد
(ب) حماية الجار:
حماية الجار، وكف الظلم عنه أثر من آثار طهارة النفس، بل مكرمة من أنبل المكارم الخلُقية في نظر الإسلام، ومما ينبه لشرف همة الرجل نهوضه لإنقاذ جاره من مصيبة نالته، أو بلاء حلّ به، وكانت حماية الجار من أشهر مفاخر العرب التي ملأت أشعارهم، وسطرتها دواوينهم.
قال حسان بن ثابت رضي الله عنه:
ولا ضيفنا عند القرى بمدفّع
وما جارنا في النائبات بمُسْلَمِ
وقال أيضاً:
يواسون مولاهُمُ في الغِنا
ويحمون جارَهم إنْ ظُلمْ
وقال حسان بن نشية:
أبوا أن يُبيحوا جارهَم لعدوِّهم
وقد ثار نقعُ الموتِ حتى تكوثرا
وكان لأبي حنيفة جار بالكوفة إذا انصرف من عمله يرفع صوته في بيته منشداً:
أضاعوني وأيَّ فَتىً أضاعوا
ليومِ كَريهةٍ وسِدادِ ثَغْرٍ
فيسمع أبو حنيفة غناءه بهذا البيت، فاتفق أن أخذ الحرس في ليلة من الليالي هذا الجار وحبسوه، ففقد أبو حنيفة صوته تلك الليلة، وسأل عنه في الغد فأخبروه بحبسه، فركب إلى (الأمير عيسى بن موسى) وطلب منه إطلاق الجار، فأطلقه في الحال، فلما خرج الفتى دعا به أبو حنيفة، وقاله له سرّاً: فهل أضعناك يا فتى؟ قال: لا، ولكن أحسنتَ وتكرمتَ، أحسن الله جزاءك، وأنشد:
وما ضرّنا أنّا قليل وجارُنا
عزيز وجارُ الأكثرين ذليل
والأصل في حماية الجار، ودفع الظلم عنه، وعدم خذلانه ما رواه الشيخان عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ولا يُسلمه (يخذله)، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرّج عن مسلم كرْبة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة".
(ج) الإحسان إلى الجار:
لا يكفي المرء في حسن الجوار أن يكف أذاه عن الجار، أو يدفع عنه بيده أو جاهه يداً طاغية، بل يدخل في حسن الجوار أن يجامله بنحو التعزية عند المصيبة، والتهنئة عند الفرح، والعيادة عند المرض، والبداءة بالسلام، وإرشاده إلى ما ينفعه بعلمه ونصحه من أمر دينه ودنياه.. وعلى العموم أن يواصله بما استطاع من إكرام..
والأصل في هذا الإحسان ما رواه الخرائطي والطبراني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عند جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أغلق بابه دون جاره مخافة على أهله وماله، فليس ذلك بمؤمن، وليس بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه، أتدري ما حق الجار؟: إذا استعانك أعنته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا افتقر عدت عليه، وإذا مرض عدته، وإذا أصابه خير هنأته، وإذا أصابته مصيبة عزَّيته، وإذا مات اتبعت جنازته، ولا تستطل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذه بقُتار ريح قِدرك إلا أن تغرف له منها، وإن اشتريت فاكهة فاهد له، فإن لم تفعل فأدْخِلها سرّاً، ولا يخرج بها ولد ليغيظ بها ولده".
وقد عدّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إكرام الجار في خصال الإيمان فقال: "من كان يؤمن بالله واليوم والآخر فليكرم جاره". الشيخان.
وقال تعالى: {وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنُبِ[2] والصّاحب بالجنْب[3] وابن السبيل} النساء: 36.
ومما يؤكد هذه الحقوق للجار القريب، والجار البعيد.. ما رواه الطبراني عن جابر رضي الله عنه: "الجيرانُ ثلاثة: جار له حق: وهو المشرك، وجار له حقان: وهو المسلم: له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له ثلاثة حقوق: مسلم له رحم، فله حق الجوار وحق الإسلام والرحم".
قال مجاهد: كنت عند عبد الله بن عمر، وغلام له يسلخ شاة، فقال: يا غلام إذا سلخت فابدأ بجارنا اليهودي – حتى قال ذلك مراراً – لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورِّثه" البخاري ومسلم.
والمتأدبون بأدب القرآن يحافظون على حقوق الجار حق الرعاية؟ قالت عائشة رضي الله عنها: "لا تبالي المرأة إذا نزلت بين بيتين من الأنصار صالحين إلا أن تنزل بين أبويها".
ومن الإحسان إلى الجار: بذل ما يطلبه من نحو النار والملح والماء، وإعارته ما اعتاد الناس استعارته من أمتعة البيت، وحاجات المنزل.. كالقدر، والصفحة، والسكين، والقدوم، والغربال.. وحمل كثير من المفسرين الماعون في قوله تعالى: {ويمنعون الماعون} على هذه الأدوات ونحوها، ذلك أن منعها دليل لؤم الطبيعة، ودناءة النفس، قال مهيار:
لجارهم من دارهم مثلُ مالَهم
على راحةٍ من عيشهم ولُغُوبِ
وكان العرب يضربون المثل في حسن الجوار بأبي دؤاد، وهو كعب بن أمامة فيقولون: "جار كجار أبي دؤاد" وكان أبو دؤاد هذا إن هلك لجاره بعير أو شاة أخلفها عليه، وإذا مات الجار أعطى أهله مقدار ديّته من ماله.
قال الخوارزمي في (مفيد العلوم): كان لعبد الله بن المبارك جار يهودي، فأراد أن يبيع داره فقيل له: بكم تبيع؟ قال: بألفين، فقيل له: لا تساوي إلا ألفاً، قال: صدقتم، ولكن ألف للدار، وألف لجوار عبد الله بن المبارك، فأخبر ابن المبارك بذلك فدعاه فأعطاه ثمن الدار، وقال: لا تبعها. ولولا ما لقيه اليهودي من ابن المبارك من حسن الخلق، وكريم المعاملة لما وقف من بيع الدار هذا الموقف!!..
(د) احتمال أذى الجار:
للمرء فضل في أن يكف عن جاره الأذى، وله الفضل في أن يجيره ويدفع عنه يد السوء، وله فضل في أن يواصله بالإحسان جهده، وهناك فضل رابع هو أن يتجاوز عن أخطائه، ويتغاضى عن هفواته، ويتلقى كثيراً من إساءاته بالصفح والحلم، ولا سيما إساءة صدرت من غير قصد، أو إساءة ندم عليها، وجاء معتذراً منها، قال الحريري في مقاماته: (وأراعي الجار ولو جار).
ولا شك أن الذي يحلم على من جَهِل عليه، ويحسن إلى من أساء إليه، ويعفو عمن ظلمه يكون في أعلى مراتب الكرامة، وفي أرفع منازل السعادة يوم القيامة..
- روى البزار والطبراني عن عبادة بن الصامت – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات؟ قالوا: نعم يا رسول الله، قال: تحلُم على من جهل عليك، وتعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك".
وكثيراً ما يكون الصفح عن المذنب، والعفو عن المسيء، دواء لسوء خلُقه، وتقويماً لانحرافه واعوجاجه، فيعود الجفاء إلى إلْفَة، والمناوأة إلى مسالمة، والبغضاء إلى محبة...، وصدق الله العظيم القائل في محكم تنزيله:
{ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسنُ، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وليٌّ حميم} فصلت: 34.
ومن المسلّم به عند علماء التربية والأخلاق أن التسرع إلى دفع السيئة بمثلها أو بأشد منها دون نظر إلى ما يترتب عليها من الأثر السيء، والنتائج الوخيمة دليل واضح على ضيق الصدر، والعجز عن كبح جماح الغضب.. وإنما يتفاضل الناس في الأخلاق والسيادة على قدر تدبّرهم للعواقب، وتبصرهم للنتائج، وإسكاتهم لثورة الانفعال إذا طغت.. ومن هنا كان الذي يملك نفسه عند الغضب من أقوى الأقوياء، ومن أعظم الأبطال في نظر النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه[4].
تلكم أهم الأصول في حقوق الجوار، وأميز الأسس في معاملة الجار.. فما على المربين إلا أن يسعوا جهدهم في تخليق الولد – منذ التمييز – على فضيلة حسن الجوار، ومراعاة حقوق الجار.. حتى إذا بلغ السن التي تؤهله لأن يتعامل مع الآخرين، ويساكنهم، ويكون بجوارهم.. كف الأذى عنهم، وحماهم من كل ظلم وإعتداء، وواصلهم بالبر والإحسان، واحتمل منهم كل ما يلقاه من إساءة وأذى..
وتخليق الولد على هذه الأصول الأربعة في حقوق الجوار لا يتم إلا بشيئين:
الأول: تلقينها شفويّاً في المناسبات وغير المناسبات..
الثاني: تطبيقها عمليّاً مع من كان من سنه من أبناء الجيران..
ولا شك أن الولد حينما يتخلق على هذه الخصال الكريمة منذ الصغر تنمو في نفسه نزعة التطلع إلى الاجتماع بالآخرين، بل يصبح إنساناً اجتماعيّاً بكل ما في هذه الكلمة من معنى، بل تتلاشى من نفسيته آفات العزلة والانكماش والانطوائية.. فيثبت وجوده حيثما كان، ويبرز شخصيته أينما وجد.. وما ذاك إلا بفضل التربية الاجتماعية التي تخلّق بها، وتدرّج عليها، وسلك وسائلها وأسبابها.. ألا فلينتبه المربون إلى الأسس التي تنمي شخصية الولد، وتجعله من أماجد الناس وفضلائهم!!..
[1] أختل: أرقب العرس من حيث لا يشعرون.
[2] الجار البعيد الذي لا يمت إليك بقرابة.
[3] من يرافقك في نحو سفر أو تعلم أو صناعة.
[4] في الحديث: "ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب".
مراعاة حقوق الآخرين - حق المعلم
ومن الحقوق الاجتماعية الهامة التي يجب أن ينتبه المربون لها، ويذكّروا بها، ويُلحوا عليها.. تربية الولد على احترام المعلم، وتوقيره، والقيام بحقه.. حتى يتنشأ الولد على الأدب الاجتماعي الرفيع تجاه من له عليه حق التعليم والتوجيه والتربية، ولا سيما إن كان المعلم يتصف بالصلاح، ويتّسم بالتقوى، ويتميز بمكارم الأخلاق..
ولقد وضع نبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه أمام المربين وصايا كريمة، وتوجيهات سامية في إكرام العلماء، وإجلال المعلمين، ليعلم الناس لهم فضلهم، وليقوم من كان له شرف التّلمذة بحقهم، ويلتزم التلاميذ الأدب معهم..
وإليكم هذه الطاقة العطرة من الوصايا والتوجيهات:
- روى أحمد والطبراني والحاكم عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس من أمتي من لم يُجِلّ كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا (حقه)".
- وروى الطبراني في (الأوسط) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والوقار، وتواضعوا لمن تعلّمون منه".
- وروى الطبراني في (الكبير) عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث لا يستخف بهم إلا منافق: ذو الشيبة في الإسلام، وذو العلم، وإمام مُقْسط".
- روى الإمام أحمد عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم لا يدركني زمان، لا يُتْبَع فيه العليم[1]، ولا يستحيا فيه من الحليم، قلوبهم قلوب الأعاجم، وألسنتهم ألسنة العرب".
- وروى البخاري عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحُد (يعني في القبر)، ثم يقول: أيهما أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدّمه في اللحد".
ونستخلص من مجموعة هذه الوصايا الأمور التالية:
• على المتعلم أن يتواضع لمعلمه، ولا يخرج عن رأيه وتوجيهه، بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر، فيشاوره فيما يقصده، ويتحرى رضاه فيما يعتمده، بل عليه أن يعلم أن ذله لمعلمه عزّ، وخضوعه له فخر، وتواضعه له رفعة.
ومما يقال: "إن الشافعي – رضي الله عنه – عوتب على تواضعه للعلماء، فقال:
أهين لهم نفسي فهمْ يُكرِمونَها
ولن تُكْرَمَ النفس التي لا تُهينُها
وأخذ ابن عباس رضي الله عنه مع جلالة قدره، وعلو منزلته بركاب زيد بن ثابت الأنصاري، وقال: "هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا".
وقال الإمام أحمد بن حنبل لخلف الأحمر: "لا أقعد إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه".
وقال الإمام الغزالي: "لا ينال العلم إلا بالتواضع، وإلقاء السمع...".
• وعلى المتعلم أن ينظر إلى معلمه بعين الإجلال، ويعتقد فيه درجة الكمال فإن ذلك أقرب إلى الاستفادة منه، والنفع به.
وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: (كنت أُصفِّح الورقة بين يدي مالك صفحاً رقيقاً هيبة لئلا يسمع وقعها).
وقال الربيع: (والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إليّ هيبة له).
وحضر أحد أولاد الخليفة المهدي عند شُريك، فاستند إلى الحائط، وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه شُريك، ثم عاد، فعاد شُريك بمثل ذلك، قال ابن الخليفة: تستخف بأولاد الخلفاء هذا الاستخفاف؟ قال: لا، ولكن العلم أجلّ عند الله من أن أضيعه[2].
وينبغي ألا يخاطب معلمه بتاء الخطاب أو كافه، بل يناديه بقوله: يا سيدي، ويا معلمي، ويا أستاذي.. وكذلك لا يذكر اسم معلمه في غيبته إلا مقروناً بما يُشعِر السامع بإجلاله وتوقيره كقوله: قال معلمنا الفاضل كذا، أو قال أستاذنا فلان كذا.. أو قال مرشدنا الفلاني كذا...
• وعلى المتعلم أن يعرف لمعلمه حقه، ولا ينسى له فضله، قال شعبة: (كنت إذا سمعت من الرجل الحديث كنت له عبداً ما يحيا)، وقال: (ما سمعت من أحد شيئاً إلا واختلفت[3] إليه أكثر ما سمعت منه).
ورحم الله شوقي حيث قال:
قم للمُعلِّم وَفّهِ التبْجيلا
كاد المعلِّمُ أن يكونَ رسولا
أَعَلِمتَ أشرفَ أو أجلّ مِنَ الذي
يبني ويُنشِئُ أنفُساً وعقولاً
وينبغي للولد المتعلم أن يدعو لأستاذه مدة حياته، ويرعى ذريته وأقاربه وأهل ودّه بعد وفاته، ويعتمد زيارة قبره، والاستغفار له، والصدقة عنه في كل فرصة سانحة، ويراعي في العلم والدين والأخلاق عادته، ويقتدي بحركاته وسكناته، ويتأدب بآدابه باعتباره الأسوة الحسنة، والقدوة الصالحة..
• وعلى المتعلم أن يصبر على سوء خلق معلمه وجفوته.. ولا يصده عن ذلك ملازمته والاستفادة منه، ويبدأ هو عند جفوة المعلم وغضبه بالاعتذار والتوبة مما وقع منه، وينسب موجب الغضب إليه، ويجعل العتب عليه، فإن ذلك أبقى لمودة أستاذه، وأحفظ لقلبه، وأنفع للطالب في دينه ودنياه وآخرته..
ومما ينقل عن بعض السلف: (من لم يصبر على التعليم، بقي عمره في عماية الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الدنيا والآخرة).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: "ذَللْت طالباً فعززتُ مطلوباً".
وقال الشافعي رحمه الله: قيل لسفيان بن عيينة، إن قوماً يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم يوشك أن يذهبوا أو يتركوك، فقال للقائل: (هم حمقى إذا هم تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي).
ولبعضهم قوله:
إن المعلم والطبيب كلاهما
لا ينصحان[4] إذا هما لم يُكرما
فاصبرْ لدائك إن جفوتَ طبيبه
واصبرْ لجهلك إن جفوتَ معلماً
• وعلى المتعلم أن يجلس بين يدي معلمه جلسة الأدب بسكون وتواضع واحترام.. مصغياً إلى أستاذه، ناظراً إليه، مُقْبلاً بكليته عليه، غير ناظر إلى يمينه أو شماله أو فوقه أو قدامه بغير حاجة...
وعلى المتعلم كذلك أن يكون متجنباً في حضرة معلمه كل ما يخل بالوقار، وينافي الأدب والحياء، فلا ينبغي أن ينظر إليه، ولا يضطرب لضجة يسمعها أو يلتفت إليها ولا سيما عند إلقاء درسه.. ولا يعبث بيديه أو رجليه أو غيرهما من أعضائه، ولا يعبث بيده في أنفه أو يستخرج منه شيئاً، ولا يفتح فاه ولا يقرع سنه ولا يضرف الأرض براحته أو يخط عليها بأصابعه، ولا يشبّك بيديه أو يلعب بإزاره، ولا يكثر كلامه من غير حاجة، ولا يحكي ما يضحك لغير عجب ولا لعجب رافعاً صوته في الضحك، فإن غلبه تبسم تبسماً بغير صوت البتّة، ولا يكثر التنحنح من غير حاجة إليه، ولا يبصق ولا يتنخّم ما أمكنه، فإن اضطر إلى إخراج النخامة من فيه يأخذ بمنديل أو ورقة تستعمل لذلك، وإذا اضطر للعطاس خفّض صوت عطاسه جهده، وستر وجهه بمنديل أو نحوه، وإذا تثاءب ستر فاه بيده بعد ردّه جهده، ومما قاله علي كرَّم الله وجهه في تبيان حق العالم على المتعلم:
(من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة، وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه، ولا تشيرنّ عنده بيديك، ولا تغمز بعينك غيره ولا تقولنّ: قال فلان خلاف قوله، ولا تغتابنّ عنده أحداً، ولا تطلبنّ عثرته، وإن زلَّ قبلت معذرته، وعليك أن توقره لله تعالى، وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته، ولا تسارر أحداً في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلحّ عليه إذا كسل، ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء..).
ولقد جمع رضي الله عنه في هذه الوصية ما فيه الكفاية، وما يشفي الغليل!!..
• وعلى المتعلم ألا يدخل على معلمه في الفصل أو البيت أو المكان المخصص له إلا باستئذان سواء كان المعلم وحده أو كان مع غيره، فإن استأذن ولم يأذن له انصرف ولا يكرر الاستئذان، وإن شك في علم المعلم به فلا يزيد في الاستئذان فوق ثلاث مرات، وليكن طرق الباب خفيفاً بأدب بأظفار الأصابع ثم بالحلقة ثم بالجرس قليلاً.. فإن كان الموضع بعيداً عن الباب فلا بأس برفع ما يُسْمِع لضرورة الأمر..
وينبغي أن يدخل على المعلم كامل الهيئة، متطهر البدن، نظيف الثياب.. لا سيما إن كان يقصد مجلس العلم، فإنه مجلس ذكر، واجتماع عبادة..
وينبغي أن يدخل على المعلم، وقلبه فارغ من الشواغل، ونفسه صافية من الأحوال النفسية.. ليعي ما يقول، وينشرح صدره لما يسمعه..، وإذا حضر مكان المعلم فلم يجده جالساً انتظره كيلا يفوّت على نفسه درسه، ولا يطرق عليه ليخرج إليه، وإن كان نائماً صبر حتى يستيقظ أو ينصرف ثم يعود…
فقد رُوي أن ابن عباس – رضي الله عنهما – كان يجلس في طلب العلم على باب زيد ابن ثابت حتى يستيقظ، فيقال له: ألا نوقظه لك؟، فيقول: لا، وربما طال مقامه وقرعته الشمس، وكذلك كان السلف يفعلون.
• وعلى المتعلم إذا سمع المعلم يذكر دليلاً لحكم، أو فائدة مستغربة، أو يحكي حكاية أو ينشد شعراً.. وهو يحفظ ذلك أصغى إليه إصغاء مستفيد له في الحال، متعطش إليه فرح به كأنه لم يسمعه قط.
قال عطاء: (إني لأسمع الحديث من الرجل وأنا أعلم به منه، فأريه من نفسي أني لا أحسن منه شيئاً)، وعنه قال: (إن الشاب ليتحدث بحديث فأسمع له كأني لم أسمعه، ولقد سمعته قبل أن يولد).
وقال أبو تمام في صفات الصديق وآداب الصداقة:
مَنْ لي بإنسان إذا أغضبتُه
وجهلتُ كان الحلم ردَّ جوابه
وإذا طربتُ إلى المُدَام شربت من
أخلاقه وسكرتُ من آدابه
وتراه يصغي للحديث بسمعه
وبقلبه ولعله أدرى به
هذا مما يُستحب في معاملة الصديق للصديق، ومعاملة المعلم أولى وأوجب. ولا ينبغي لطالب العلم أن يكرر سؤال ما يعلمه، ولا استفهام ما يفهمه فإنه يضيع الوقت، وربما أضجر المعلم، قال الزهري: (إعادة الحديث أشد من نقل الصخر).
وينبغي ألاّ يُقْصِّر في الإصغاء والفهم أو يشتغل ذهنه بفكر أو حديث ثم يستعيد المعلم ما قاله لأن ذلك إساءة أدب، بل يكون مصغياً لكلامه، حاضر الذهن من أول مرة.
وإذا لم يسمع كلام المعلم لبعده أو لم يفهمه بعد الإصغاء إليه، فله أن يسأل المعلم إعادته وتفهيمه بعد بيان عذره بسؤال لطيف.
تلكم أهم الآداب التي يجب أن يتلقنها الولد من معلميه ومربيه، وهي آداب تربوية نبيلة، وحقوق اجتماعية كريمة…
ومن المعلوم أن الولد حينما يفتح عينيه على تلقين هذه الآداب، ويتربَّى منذ نعومة أظفاره على التخلق بهاتيك الحقوق.. فلا شك أن الولد أدى ما عليه من حقوق تجاه من كانوا له سبباً في العلم، والتربية، والأخلاق، وتكوين الشخصية..
ومما لا جدال فيه أن التركيز من قِبَل المعلمين والمربين في إعداد الولد خلقياً يجب أن يكون مقدماً على تكوينه العلمي والثقافي، لأن التحلي بالمكارم – كما يقولون – مقدم على تعليم المسائل..
لهذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يهتمون بأدب أطفالهم وتلامذتهم أكثر مما يهتمون في تلقينهم العلم، وتزويدهم المعرفة..
قال الحبيب بن الشهيد لابنه: (يا بني اصحب الفقهاء والعلماء، وتعلم منهم، وخذ من أدبهم، فإن ذلك أحب إليّ من كثير من الحديث).
وقال مخلّد بن الحسين لابن المبارك: (نحن إلى كثير من الأدب أحوج إلى كثير من الأحاديث).
وقال بعض السلف لابنه: (يا بني لأن تعلم باباً من الأدب أحب إليّ من أن تعلم سبعين باباً من أبواب العلم).
وقال سفيان بن عيينة: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، وعليه تعرض الأشياء على خُلُقه وسيرته وهديه.. فما وافقها فهو الحق، وما خالفها فهو الباطل).
وقال ابن سيرين: (كانوا يتعلمون الهدي[5] كما يتعلمون العلم).
ومما يجب التنبيه له أن هذه الآداب التي يجب التزامها هي في حق المعلمين، الأتقياء في أنفسهم، الأوفياء لدينهم، الذين يرجون لله وقاراً، ويؤمنون بالإسلام عقيدة وشريعة، وبالقرآن منهاجاً ودستوراً.. هؤلاء يجب أن يلقن الولد احترامهم، وأن يعرف فضلهم، وأن يؤدي لهم حقهم.. ما داموا على الهدى والصراط المستقيم..
أما المعلمون الملحدون، والمربون اللادينيون فهؤلاء ليس لهم في القلوب إجلال، ولا في النفوس احترام.. لكونهم أهدروا إنسانيتهم بالإلحاد، وأسقطوا اعتبارهم ومهابتهم بالكفر والضلال..
فعلى الأب أن يغضب لله، حين يعلم أن معلماً ملحداً يلقن ولده مبادئ الكفر، ومفاهيم الزيغ والإلحاد.. بل عليه أن يقيم الدنيا ويقعدها، وأن تغلي في عروقه حمية الإسلام.. تجاه هذه الشراذم الباغية، والحثالات العميلة الخائنة.. حتى يرى هذه الجراثيم البشرية قبعت في جحورها، وتوارت في أوكارها.. فما عاد يرتفع لهم رأس، أو ينطق لهم لسان!!..
{بل نقذِفُ بالحقِّ على الباطلِ فيدمغه فإذا هو زاهقٌ ولكم الويل مما تصفون} الأنبياء: 18.
ورحم الله من قال:
إن عادت العقرب عُدْنا لها
وكانتِ النعلُ لها حاضرة
ولا يكفي الأب أن يغضب لله في الوقوف أمام معلم ملحد، ومربٍّ ضال خائن.. بل عليه أن يغرس في ولده خلق الجرأة الأدبية، والمجاهرة بالحق.. لينشأ الولد على مقاومة أعداء الإسلام مهما كان لهم من القوة والتسلط والنفوذ..
وحينما يعلم أعداء الله والإسلام من معلمين وغير معلمين.. أن الأمة لهم بالمرصاد، وأن الاستنكار والمواجهة لأفعالهم وأقوالهم منبعث من الكبار والصغار!!..
هل يتجرأ أحد منهم على أن يجهر بإلحاد؟
هل يستطيع مجرم من هؤلاء أن يتهجم على الإسلام؟
هل نسمع أو نرى أن عدواً تطاول على ذات الله، أو طعن بشخصية الرسول عليه الصلاة والسلام؟ حتماً الجواب، لا!!..
إذن فما على الآباء إلا أن يفهموا هذه الحقيقة، وأن يؤدوا ما عليهم من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يقفوا في وجه كل عميل خائن وأن يُخَلّقوا أولادهم بخلق الجرأة والمجابهة.. حتى لا يتمادى العُملاء، ولا يخرج من جحورهم الأعداء والجبناء، وحتى تبقى دائماً العزة لله ولرسوله وللمؤمنين.. ورحم الله امرءاً أراهم من نفسه قوة، ومن جهاده عزة، ومن جرأته قولة حق!!..
[1] يتعوذ من زمن يعرض فيه الناس على العالم الفقيه.
[2] لكونه مستنداً غير متأدب بجلسته في حلقة العلم.
[3] ترددت إليه للخدمة.
[4] ليس ذلك على إطلاقه لأن بعض المعلمين والأطباء يعملون لوجه الله، لا يريدون من وراء عملهم جزاء ولا شكوراً.
[5] الهدي: أي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وسيرة السلف.
مراعاة حقوق الآخرين - حق الرفيق
من الأمور الهامة التي يجب أن يلحظها المربون في الولد اختيار الرفيق المؤمن، والجليس الصالح.. لما له من تأثير كبير في استقامة الولد، وصلاح أمره، وتقويم لي من أنا؟ بل قل لي من تصاحب، تعرفني مَن أنا!!).
ورحم الله الشاعر الذي يقول:
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه
فكل قرين بالمُقارن يقتدي
ولنستمع إلى المُربي الأول عليه أفضل الصلاة والتسليم كيف يوجه الآباء والمربين في اختيار الرفقة الصالحة لأولادهم، ومن لهم حق التربية عليهم.
- روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مثل الجليس الصالح، والجليس السوء كمثل حامل المسك، ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يُحذِيَك[1]، أو تشتري منه، أو تجد مه ريحاً طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، أو تجد منه ريحاً منتنة".
- وروى أبو داود والترمذي عنه عليه الصلاة والسلام: "لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي".
- وروى ابن عساكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إياك وقرين السوء فإنك به تُعرف".
- وروى الترمذي وأبو داود عنه عليه الصلاة والسلام "المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل".
من هذا كله وجب على المربي أن ينتقي للولد – ولا سيما بعد أن يبلغ سن التمييز – أن ينتقي له الزمرة الصالحة من الرفقاء من سنه، يختلط بهم، ويلهو معهم، ويدرس وإياهم، ويتفقدهم بالزيارة، ويعودهم إذا مرضوا، ويقدم لهم الهدية إذا نجحوا، ويذكرهم إذا نسوا، ويعينهم إذا احتاجوا.. وهذا – لا شك – ينمي في الولد النزعة الاجتماعية التي فُطر عليها، ويجعل منه في المستقبل رجلاً متوازناً سوياً يؤدي حق المجتمع على الوجه الصحيح الذي يرضي الله عز وجل، ويأمر به الإسلام!!..
ولكن ما هي أهم حقوق المصاحبة التي يجب على المربين أن يرسخوها في الولد؟
الحقوق هي كما يلي:
(أ) السلام[2] إذا لقيه:
لما روى الشيخان عن عبد الله عن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما – أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: "تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف".
وروى مسلم عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم".
(ب) عيادته إذا مرض:
لما روى البخاري عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عودوا المريض، وأطعموا الجائع، وفكّوا العاني (الأسير)".
وروى الشيخان عن أبي هريرة – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس".
(ج) تشميته إذا عطس:
لما روى البخاري عن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله يصلح بالكم".
(د) زيارته في الله:
لما روى ابن ماجة والترمذي.. عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من عاد مريضاً أو زار أخاً في الله ناداه منادٍ بأن طبْتَ وطاب ممشاك، وتبوأت من الجنة منزلاً".
وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أن رجلاً زار أخاً له في الله في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى له على مدرجته (الطريق) ملكاً فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخاً لي في هذه القرية، قال: هل لك من نعمة تربُّها عليه (تقوم بها)؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى، قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه".
(هـ) إعانته وقت الشدة:
لما روى الشيخان عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسْلِمهُ (لا يترك نُصرَتَه)، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرّج عن مسلم كربة فرّج الله عنه كربة من كُرَبِ يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة".
(و) إجابة دعوته إذا دعاه:
لما روى الشيخان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس".
(ز) التهنئة بالشهور والأعياد مما اعتاده الناس:
لما روى الديلمي عن ابن عباس – رضي الله عنهما - :"من لقي أخاه عند الانصراف من الجمعة فليقل تقبل الله منا ومنك".
وروى صاحب المقاصد عن خالد بن معد أنه لقي واثلة بن الأسقع في يوم العيد فقال له: تقبل الله منا ومنك، فقال له واثلة: مثل ذلك.
وجا في الصحيحين أن طلحة قام لكعب بن مالك وهنأه بتوبة الله عليه.
وروى صاحب (الجامع الكبير) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم: "أتدرون ما حق الجار (ويدخل الرفيق)؟ إن استعان بك أعنته، وإن استقرضك أقرضته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته...".
(ح) المهاداة في المواسم والمناسبات:
لما روى الطبراني في (الأوسط) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "تهادوا تحابوا"، وللطبراني في (الأوسط) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا نساء المؤمنين تهادين ولو فرسن[3] شاة فإنه ينبت المودة، ويذهب الضغائن"، وللديلمي عن أنس مرفوعاً: (عليكم بالهدايا فإنها تورث المودة، وتذهب بالضغائن)، وأخرج الإمام مالك في الموطأ (تصافحوا يذهب الغِلّ (الحقد)، وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء).
ومما يتفرع عن حق الرفيق المؤمن الدائم حق الرفيق المؤقت، وهو الذي يصحبك في سفر أو دراسة أو وظيفة.. وهو الذي عبر عنه القرآن الكريم حين قال: {والصاحب بالجنب}. هذا الرفيق ينبغي أن ينال ممن جاوره كل عطف ورعاية وإكرام، وتعاون وإيثار، ولين جانب، وكرم أخلاق. وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم – وهو القدوة الصالحة – كان يعطي لأمته الأسوة الحسنة في ملاطفة أصحابه في السفر والحضر، والسلم والحرب، والحلّ والترحال..
أسند الطبري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه رجل من أصحابه وهما على راحلتين، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم غيْضة (مجتمع شجر)، فقطع قضيبين أحدهما معوج، فخرج وأعطى لصاحبه القويم (أي الجيد منه)، فقال الرجل: كنت يا رسول الله أحق بهذا! فقال: كلا يا فلان إن كل صاحب يصحب آخر فإنه مسؤول عن صحابته ولو ساعة من نهار".
وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: (للسفر مروءة وللحضر مروءة، فأما المروءة في السفر فبذل الزاد، وقلة الخلاف على الأصحاب، وكثرة المزاح في غير مساخط الله، وأما المروءة في الحضر فالإدمان إلى المساجد، وتلاوة القرآن، وكثرة الإخوان في الله عز وجل".
ومما ينسب لبعض بني أسد قولهم:
إذا ما رفيقى لم يكن خلف ناقتي
له مركب فضلا فلا حمِلَت رجِلْي
ولم يك من زادي له شطرُ مِزودي
فلا كنت ذا زادٍ ولا كنتُ ذا فضلِ
شريكان فيما نحن فيه وقد أرى
عليّ له فضلا بما نال من فضلي
تلكم – أيها المربون – أهم الأسس والقواعد في تلقين الولد منذ أن يفتح عينيه – حق الرفيق، واحترام الصديق.. وهي من أعظم العوامل في تنمية النزعة الاجتماعية، وتقوية ظاهرة المحبة في الله لدى الولد، هذه النزعة حينما تقوم على أسس المحبة والإخلاص، والوفاء والإيثار، والبذل والتعاون.. فإن دعائم التكافل والسلام والاستقرار تترسخ في المجتمع المسلم، وإن مبادئ العدل والإخاء والمساواة.. تنتشر في ربوع الأرض، وأطراف المعمورة.. لماذا؟ لأن الفرد المسلم أعطى لكل ذي بصيرة النموذج الحي عن الإسلام في سلوكه وأخلاقه، وملاطفته ومعاملته.. فما أحوج المجتمع الإسلامي إلى مربين أفاضل، وآباء أكارم.. يغرسون في الولد منذ نشأته هذه الأسس من التربية الفاضلة، والأخلاق القويمة.. حتى ينشأ الولد على كريم الخصال، ويترعرع على أفضل المكارم، وإنكار الذات!!..
[1] يحذيك: يعطيك.
[2] وكيفية السلام وآدابه ستأتي في مبحث "التزام الآداب الاجتماعية" إن شاء الله.
[3] فرسن: ظلف الشاة (أي المقدم).
مراعاة حقوق الآخرين - حق الكبير
الكبير هو من كان أكبر منك سناً، وأكثر منك علماً، وأرفع تقوى وديناً، وأسمى جاهاً وكرامة ومنزلة..
فهؤلاء إن كانوا مخلصين لدينهم، معتزين بشريعة ربهم.. فيجب على الناس أن يعرفوا لهم فضلهم، ويؤدوا لهم حقهم، ويقوموا بواجب احترامهم.. امتثالاً لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي عرَّف المجتمع فضلهم، وأوجب على الناس حقهم..
وإليكم طاقة عطرة من توجيهاته الكريمة في توقير الكبير:
- روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أكرمَ شابٌّ شيخاً لسنّه إلا قيّض الله (أي قدّر) له من يكرمه عند سنّه".
- وروى أبو داود والترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: "ليس منّا من لم يرحم صغيرنا، ويعرف حق كبيرنا".
- وروى أبو داود عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن العالي فيه والجافي عنه (أي التارك له)، وإكرام ذي السلطان المقسط (العادل)".
- وروى أبو داود عن ميمون بن أبي شبيب رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها مرّ بها سائل فأعطته كِسْرة (قطعة خبز)، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل فقيل لها في ذلك؟ فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنزلوا الناس منازلهم" وفي رواية: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نُنْزِل الناس منازلهم).
- وروى مسلم عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أراني في المنام أتسوَّك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر (منهما)، فقيل لي: كبّر فدفعته إلى الأكبر منهما".
ونستخلص من مجموعة هذه الأحاديث الصحيحة الأمور التالية:
(أ) إنزال الكبير منزلته اللائقة به:
كأن يستشار في الأمور، ويقدم في المجلس، ويبدأ به بالضيافة.. تحقيقاً لقوله عليه الصلاة والسلام: "أنزلوا الناس منازلهم". ومما يؤكد هذا ما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن شهاب بن عبّاد أنه سمع بعض وفد عبد القيس وهم يقولون: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشتدّ فرحهم، فلما انتهينا إلى القوم أوسعوا لنا، فقعدنا، فرحب بنا النبي صلى الله عليه وسلم، ودعانا، ثم نظر إلينا، فقال: من سيدكم وزعيمكم؟ فأشرنا جميعنا إلى المنذر بن عائذ.. فلما دنا منه المنذر أوسع القوم له حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم.. فقعد عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحب به وألطفه، وسأله عن بلادهم.. إلى آخر الحديث...
ومن الأمور المسلم بها والمجمع عليها لدى أهل الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبدؤون بالضيافة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم من كان على يمينه، فظل هذا الفعل سنة متبعة من هديه عليه الصلاة والسلام.
(ب) البدء بالكبير بالأمور كلها:
كأن يتقدم الكبير على الصغير في صلاة الجماعة، وفي التحدث إلى الناس، وفي الأخذ والعطاء عند التعامل.. لما روى مسلم عن أبي مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: (استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم لِيَليني منكم أولو الأحلام والنُّهى (هم الرجال البالغون) ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم).
وروى الشيخان عن أبي يحيى الأنصاري قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيّصة ابن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صُلح، فتفرقا فأتى محيّصة إلى عبد الله وهو يتشحّط في دمه قتيلاً ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيّصة وحويّصة ابنا مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم، فقال – عليه الصلاة والسلام - :"كبّر كبّر" (أي يتكلم الأكبر سناً)، وهو – أي عبد الرحمن - أحدث[1] القوم.. إلى آخر الحديث وسبق أن ذكرنا قبل قليل حديث السواك، وأنه عليه الصلاة والسلام أمر في المنام أن يناوله إلى الرجل الأكبر.
(ج) الترهيب من استخفاف الصغير من الكبير:
كأن يهزأ منه، ويسخر عليه، ويوجه كلاماً سيئاً إليه، ويسيء الأدب في حضرته، وينهر في وجهه.. لما روى الطبراني في الكبير عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ثلاث لا يستخف بهم إلا منافق: ذو الشيبة في الإسلام، وذو العلم، وإمام مقسط".
ويتفرع عن هذه المعاني في توقير الكبير فضائل اجتماعية شرعية ترتبط بالاحترام، فعلى المربين أن يُخلّقوا أولادهم عليها، ويأمروهم بها:
(أ) الحياء:
وهو خُلُق يبعث على ترك القبيح، ويمنع من التقصير في حق الكبير، ويدفع إلى إعطاء ذي الحق حقه...
لهذا (كان الحياء خيرا كله) كما روى الشيخان عن عمران بن حصين.
ومما يدل على فضيلة الحياء ما رواه الطبراني عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة: "لو كان الحياء رجلاً لكان رجلاً صالحاً، ولو كان الفحش رجلاً لكان رجل سَوْء".
وروى ابن ماجة والترمذي عن أنس – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه".
وروى مالك وابن ماجة عن زيد بن طلحة بن ركانة يرفعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن لكل دين خلُقاً، وخلق الإسلام الحياء".
وروى البخاري ومسلم عنه عليه الصلاة والسلام: ".. والحياء شعبة من الإيمان".
فلا عجب بعد هذا التوجيه النبوي في فضيلة الحياء أن يتخلق أبناء الصحابة بهذا الخلق الرفيع، وأن تظهر بوادره أمام من يكبرهم سناً، ويعلوهم منزلة..
روى الشيخان عن أبي سعيد – رضي الله عنه قال - : (لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاماً فكنت أحفظ عنه فما يمنعني من القول إلا أن ههنا رجالاً هم أسنّ مني).
(ب) القيام للقادم:
القيام للقادم كالضيف أو المسافر أو العالم أو الكبير.. أدب اجتماعي نبيل يجب أن يؤمر الولد به، ويتخلق عليه للأدلة التالية:
(أ) روى البخاري وأبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما رأيت أحداً أشبه سمتاً ودلاً وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم – في قيامها وقعودها – من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها وقبلته وأجلسته في مجلسها".
(ب) وروى النسائي وأبو داود عن أبي هريرة – رضي الله عنه - :"كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا فإذا قام قمنا قياماً حتى نراه دخل إلى بعض أزواجه".
(ج) وروى أبو داود عن عمر بن السائب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالساً فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه، ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من الجانب الآخر فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه.
(د) وروى الشيخان أن سعد بن معاذ لما دنا إلى المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: "قوموا إلى سيدكم أو خَيْركم".
(هـ) ومن الأحاديث الصحيحة الثابتة الدالة على جواز القيام ما جاء في حديث كعب ابن مالك المتفق عليه، وهو يقص خبر تخلّفه عن غزوة تبوك قال: فانطلقت أتأمّم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلقاني الناس فوجاً فوجاً يهنئوني بالتوبة، ويقولون: لتَهْنِك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله الناس، فقام إليّ طلحة بن عُبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني..
وقد استدل أهل العلم والاجتهاد من مجموع هذه الأحاديث وغيرها على جواز القيام لأهل العلم والفضل في المواسم والمناسبات.
وأما ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن القيام فمحمول على من قصد القيام لذاته، واستشرفه وتطلّع إليه، ومحمول كذلك على تقليد صفة خاصة من القيام، فيها معنى الكِبْر، والتعظيم كان ينتهجها الأعاجم في تعظيم بعضهم بعضاً كأن يقعد المعظّم مكرماً مبجلاً والناس حوله واقفون.
(ج) تقبيل يد الكبير:
ومن الآداب الاجتماعية التي ينبغي أن يعتادها الولد، ويحرص المُربِّي على تلقينها والتخلق بها أدب تقبيل يد الكبير، لما لهذا الأدب الاجتماعي من أثر كبير في تعليم الولد التواضع والاحترام وخفض الجناح وإنزال الناس منازلهم..
ومما يدل على هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وعمل الصحابة، واجتهاد الأئمة:
(أ) أخرج أحمد والبخاري في (الأدب الصغير)، وأبو داود، وابن الأعرابي عن زارع وكان في وفد (عبد القيس) قال: لما قدمنا المدينة جعلنا نتبادر من رواحلنا، فنقبِّل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله.
(ب) وروى البخاري في الأدب المفرد عن الوازع بن عامر قال: قدمنا، فقيل ذلك رسول الله، فأخذنا بيده ورجليه نقبلها.
(ج) وأخرج ابن عساكر عن أبي عمار: أن زيد بن ثابت قُرِّبت له دابة ليركبها فأخذ ابن عساكر بركابها، فقال زيد: تنحّ يا ابن عمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بكبرائها وعلمائنا، فقال زيد: أرني يدك! فأخرج يده فقبلها فقال: هكذا أُمرنا أن نفعل بأهل بيت نبيّنا!!..
(د) وروى البخاري في الأدب المفرد عن صهيب قال: رأيت عليّاً يقبّل يد العباس ورجليه.
(هـ) وأخرج الحافظ أبو بكر المقريّ عن أبي مالك الأشجعي قال: قلت لابن أخي أوفى ناولني يدك التي بايعت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناولنيها فقبّلتها.
هذا غيض من فيض مما ثبت في تقبيل يد أهل العلم والفضل.. فما على المربين إلا أن يعوّدوا أطفالهم على هذا الخلق الكريم، والأدب الرفيع.. حتى ينشؤوا على التواضع الجمّ، والأخلاق العالية الندية.. في احترامهم الكبار، وتوقيرهم العلماء، وتعاملهم مع الآخرين..
ولكن على المربين أن ينتبهوا في تخليق الولد على القيام والتقبيل إلى أمرين هامين:
الأول: ألاَّ يُغالوا[2] في ذلك، لما للمغالاة من تغاض عن المساوئ، ومجافاة للحق، وانتكاس لحقيقة الاحترام، وتحطيم لشخصية الولد النفسية.
الثاني: ألاَّ يزيدوا عن الحد الذي أمر به الشرع الإسلامي كالانحناء أثناء القيام، أوالركوع أثناء التقبيل.
تلكم أهم الأسس التي وضعها الإسلام في مراعاة حقوق الآخرين، فما على المربين إلا أن ينشِّئوا الأولاد عليها، ويلقنوهم إياها، ويرشدوهم إليها، حتى يتدرج الولد على احترام الكبير، وإكرام ذي الشيبة.. وحتى يفهم منذ نعومة أظفاره حق من يَكبرُه سناً، وأدب من يفوقه علماً وفضلاً ومنزلة..
ولا شك أن المُربي حين يضع بين يدي الجيل هذه القواعد في تخليق الولد على احترام الآخرين، والتأدب معهم، والإحسان إليهم.. فالولد يندفع بكليته إلى توقير ذوي الفضل.. وإجلال ذي الشيبة.. وهذا لعمري غاية الأدب. ومنتهى التوقير والاحترام. فما أحوجنا إلى مربين أكارم. ومعلمين أفاضل.. يفهمون حقائق التربية في الإسلام، ثم ينطلقون جادِّين عازمين إلى تعويد هذا الجيل هاتيك المكارم، وتخليقهم على هذه الفضائل، وتأديبهم على هذه الخصال!!.. فإن هم انطلقوا في هذه السبيل.. وصمموا على تنفيذ هذا المنهج وصلت الأمة الإسلامية إلى الذروة في الخُلق الاجتماعي النبيل. والأدب الإسلامي الرفيع.. وعندئذ يفرح المؤمنون بالجيل الناشئ، والمجتمع الفاضل، والاستقرار المنشود..
[1] أي أصغرهم سناً.
[2] المغالاة: هو الإفراط في القيام والتقبيل عن الحد المعتاد المتعارف عليه.
يتبع
السبت 19 شعبان 1447 هـ - 7 فبراير 2026
أخبار النافذة
تركيا توقع صفقة أسلحة مع مصر بقيمة 350 مليون دولار
إسرائيل تسلّح المليشيات في غزة.. صحف عبرية تكشف عودة خطط الحرب القذرة الصهيونية تحت مظلة وقف إطلاق النار
هلاك قاضي الإعدامات محمد ناجي شحاتة.. غضبٌ ينفجر وجرح مازال مفتوحا
رغم شهادات الشهود.. استمرار الإخفاء القسري للشاب عمر أبو النجا للعام السابع على التوالي
سجل حافل بالأحكام القاسية.. "قاضي الإعدامات" يمثل أمام محكمة العدل الإلهية
حملة واسعة تطالب تركيا بتحرك دبلوماسي عاجل للإفراج عن عبد الرحمن القرضاوي من سجون الإمارات
غزة تحت النار رغم التهدئة: قتلى وعمليات نسف واسعة وتفاقم إنساني مع تصاعد خروقات وقف إطلاق النار
فيضانات الشمال في المغرب: إجلاء جماعي وآلاف المهددين بينما الخطر لم ينتهِ بعد