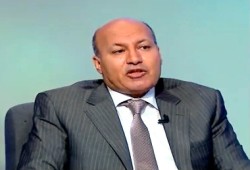الإخوان المسلمون في الأردن.. مفترق طرق إستراتيجي

الأربعاء 23 أبريل 2025 01:00 م
بقلم: محمد أبو رمان
تقف جماعة الإخوان المسلمين في الأردن عند مفترق طرق استراتيجي في إعادة تعريف دورها وعلاقتها بالدولة والمجتمع، وإذا كانت المجموعة الشبابية (16 شخصًا)، التي ينتمي أغلب أعضائها إلى جماعة الإخوان المسلمين واتّهموا بمحاولة تصنيع أسلحة وحيازتها، وأعلنت الحكومة القبض عليهم وتحويلهم إلى القضاء، بمثابة البؤرة الساخنة حالياً في علاقة "الإخوان" بالدولة، فإنّ هذه القضية جزءٌ من سياقٍ من التراكمات والأزمة المفتوحة المتصاعدة بين الجماعة ومؤسّسات القرار في الدولة، وقد أخذت الأزمة خطّاً تصاعدياً متّصلاً منذ أحداث "الربيع العربي"، حتى وصلت اليوم إلى الذروة مع هذه القضية.
ثمّة أزمة ثقة متدحرجة بين الطرفَين، لكنّ الدولة بقيت تعامل الجماعة، ومعها حزب جبهة العمل الإسلامي، ضمن قواعد اللعبة السياسية، ووفق سياسة الاحتواء وعدم الصدام الجذري، بالرغم من بروز أزماتٍ عديدة في مراحلَ ومفاصلَ مختلفة، لكن اللحظة الراهنة مختلفة بدرجة كبيرة عمّا حدث سابقاً، والسبب يعود إلى أنّنا أمام مسارٍ مختلف في أروقة الجماعة، حتى لو لم تكن المجموعات التي أعُلنت (وهذا مؤكّد) تعمل بموافقة القيادة ومباركتها، إلا أن هنالك سياقاً داخلياً في الجماعة وقاعدتها التنظيمية هو ما أدّى إلى بروز هذه المجموعات التي حاولت الانتقال من عملية تهريب الأسلحة إلى عملية التصنيع، وهذه النقطة، بالنسبة إلى مؤسّسات القرار، نقطة التحوّل (Tipping Points) التي كان الموقف (بعد إطلاع "مطبخ القرار" عليها) أن يتم تجاوز الحساسيات كلّها، التي تحدّد عادةً مواقفَ الدولة وقراراتها تجاه "الإخوان"، وأخذ موقف حاسم وواضح، ووضع حدّ لمسار، إذا تدحرج وجرى التغاضي عنه سيؤدّي إلى ما هو أخطر.
دعونا نتجاوز الراهن بين أنصار الجماعة والمتعاطفين معها (وهم بالمناسبة قاعدة كبيرة جدّاً) من جهة، والجمهور الساخط على الجماعة ومواطنين كثيرين صُدموا من القضية الجديدة، من جهة أخرى. ولنقل إن هنالك اعترافاً من الجميع بأنّ الشبان كانوا يخطّطون لعمليات أو لتصنيع أسلحة وتهريبها إلى الضفة الغربية، بغضّ النظر عن وجود صواريخ مداها قصير (ما قد يؤشّر إلى احتمال أن تكون موجّهةً إلى الداخل)، فلنقبل بالحدّ الأدنى (المتّفق عليه من الجميع)، ولا نتحدّث هنا قضائياً، فالملفّ اليوم في المحكمة، إنّما في البُعد السياسي، وتحديداً علاقة الدولة بالجماعة. إذاً، نحن أمام مجموعاتٍ من الشبان الذين قرّروا القيام بعملية تصنيع أسلحة وتهريبها أو القيام بعمليات ضدّ جيش الاحتلال في الضفة الغربية، ولنقل إنّ هنالك اعترافاً وإقراراً بأنّ هذا الأمر خُطّط من جهات خارج الأردن كانت مرتبطةً بمحور الممانعة وإيران، بعد أنّ وُضع مخطّط بتفعيل الساحات المحيطة بإسرائيل في العام 2021، وبدأت عملية بناء خلايا مسلّحة في لبنان، بينما منع النظام السوري السابق ذلك بوضوح، وأبلغ إيران رفضَه المطلق، وجرى العمل على المخطّط في الأردن باختراق مجموعة من شبان "الإخوان" (هذه المعلومات أخبر بها كاتبُ هذه السطور أحدَ القياديين المهمّين في ما سمّي حينها "محور الممانعة"). لذلك، من الضروري الإشارة إلى أنّ التخطيط وعمل هذه المجموعات لم يبدأ كلّه بعد "طوفان الأقصى"، ولا بعد حرب الإبادة في غزّة، فقط، إنّما قبل ذلك. لكن بالضرورة، ما حدث هنالك أثّر بدرجة كبيرة عاطفياً ونفسياً في كثيرين من هؤلاء الشبّان وغيرهم.
بالعودة إلى قضية الشبان المقبوض عليهم، نحن إذاً أمام مجموعات منهم انتقلت من فكرة التهريب إلى التصنيع، وبعضها على علاقة بـ"جهات خارجية"؛ وهذا هو الحدّ الفاصل بين مسارَين، فالتراخي مع فكرة عمل مسلّح وتصنيع أسلحة وتخزينها في مواقع خطيرة، وسط تجمّعات سكّانية كبيرة، وبناء مخازن وشبكات، والتعامل مع مهرّبين خارجيين، وأموال وتوجيهات تأتي من الخارج، يعني عدم الإقرار بوجود دولة وعدم الاعتراف بسيادتها أولاً. وثانياً، يعني مساراً مختلفاً تماماً حتى لو قيل إنّ السلاح ليس للداخل بل للتصدير، فما المانع غداً تحت المبرّرات نفسها في مواجهة المشروع الصهيوني أن يصبح أيضاً للداخل، وهنا السؤال المهمّ (والرئيس) الموجّه إلى قيادة الحركة الإسلامية: ما هو الخطّ الفاصل أيديولوجياً وتنظيمياً وسياسياً بين الحركة الإسلامية، التي عملت عقوداً لإقناع الجميع بأنّها حركة مدنية سياسية سلمية تؤمن تماماً بالديمقراطية، وخطّ الجماعات الجهادية المتطرّفة، التي رأت السلاح الخيار الاستراتيجي في تحقيق الأهداف السياسية، فالخطّ الفاصل إذا لم تُعِدْ قيادة الإسلاميين ترسيمه بصورةٍ جليّةٍ وواضحةٍ سيكون رخواً ومن السهل قطعه.
وجود بنية عسكرية بدأت تتشكّل (تحت أيّ ذريعة) مسار مختلف عن مجمل الأزمة السابقة بين الحركة والدولة، مسألة تحتاج معالجة فورية وفق إدراك المسؤولين الأردنيين، لأنّ التراخي مع هذا المسار قد يقود إلى مسار خطير لا يريد الأردنيون استذكاره؛ عندما كان العمل المسلّح عبر الحدود بذريعة مواجهة الاحتلال، ثمّ انتقل، مع الوقت، إلى الداخل تحت ذرائع شبيهة، وكان تراخي الدولة في البداية بالتعامل معه سبباً في الوصول إلى مرحلةٍ أكثر خطورة على الاستقرار والسلم المجتمعي وسيادة الدولة وهيبتها. الأمر الآخر، لدينا عبرة في التجارب الأخرى، التي نمت فيها حواضن ومجموعات صغيرة للعمل المسلّح، وكبرت إلى أن أصبحت دولةً داخل الدولة، وباتت تشكّل رقماً صعباً في الداخل، ومعادلةً داخلية - خارجية، وانتهى الأمر إلى مرحلة "الدولة الفاشلة"، غير القادرة على حماية سيادتها وحماية مواطنيها وحصرية استخدام القوة المسلّحة والجيش، فلا توجد دولة تقبل بأن تكون مسرحاً (وساحةً) لعمليات تهريب أسلحة وتصنيعها، حتى لو كانت ممرّاً وليست مقرّاً، وذلك أضعف الإيمان، فما بالك عندما يتعلّق الأمر بالتعامل مع واقع جيو - استراتيجي خطير؛ الدولة والمجتمعات تُختطَف من حولنا، ونحن (في الأردن) آمنون وسالمون من ذلك كلّه!
قد يقول قائل، وفي قوله وجاهة وحصافة، لماذا لا نرى القصّةً من منظور مختلف ومغاير؛ هؤلاء مجموعة من الشبان العاطفيين الذين تفاعلوا مع ما يحدُث في غزّة والضفة الغربية، ولم يحتملوا المجازر والإبادة والحرب القاسية القذرة التي تشنّها إسرائيل على الأشقاء الفلسطينيين والأطفال والنساء... فلماذا لا يُتعامل مع القضية عند هذا الحجم وليس أكثر؟ ولماذا تُرفع إلى مستوى ترسيم العلاقة مع "الإخوان" وجبهة العمل الإسلامي؟... ليس كاتب هذه السطور مع التضخيم والتهويل، وفي الوقت نفسه، هو ليس مع التهوين والتسخيف، فلتوضع المسألة في حجمها. لكنْ، من المهم استحضار السياق الخطير الذي قاد إلى ذلك؛ بخاصّة منذ "طوفان الأقصى" (بالرغم من أنّ الأزمة المتدحرجة بدأت قبله)، فقد سُمح بالمسيرات والمظاهرات والفعّاليات بصورة كبيرة في الأردن، وحظيت الأردن بأكبر كمٍّ من الفعّاليات في العالم تجاه غزّة، مقارنةً بأيّ دولةٍ أخرى، بالتوازي مع الموقف الرسمي المندفع بشدّة دبلوماسياً وسياسياً في المواجهة مع إسرائيل والدفاع عن الفلسطينيين والمطالبة بوقف الحرب البربرية على غزّة، وبعضهم بدأ بالتندّر بأنّ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي هو وزير خارجية للفلسطينيين وليس للأردن. ولو حُسبت مواقفه وجولاته العالمية والخارجية، لحصل على رقم قياسي عالمي لهذا الجهد. بالرغم من ذلك كلّه، لم يحظَ الموقف الرسمي إلّا بإشادة خجولة ومتأخّرة ومحدودة من قيادة الإسلاميين ومواقفهم الرسمية، بينما غلب طابع المناكفة والنديّة على خطابهم وسلوكهم مع مؤسّسات الدولة.
كان الطلب الرسمي الواضح من الإسلاميين: يمكنكم أن تتظاهروا في أيّ مكان لكن بعيداً من نقاطٍ حسّاسةٍ وحرجةٍ، أولاها الحدود. فالذهاب إلى الحدود هي مسيراتٍ لا تقدّم ولا تؤخّر إلا في إرهاق الجيش والاستفزاز الداخلي، لأنّ جمهوراً غير مسلّح يصل إلى الحدود لن يغيّر موازين القوى. وثانيتها السفارة الإسرائيلية، الخالية أصلاً بعد طرد البعثة منها، لكن الإصرار حدث على الاقتراب من هاتَين النقطتَين، وعلى تصوير الأمن الأردني كأنّه ضدّ المتظاهرين، وتحويل جزء من المواجهة كأنّه داخلي، فضلاً عن تمكّن بعض المتظاهرين من الوصول إلى السفارة الخالية، ومباركة أحد قادة الإسلاميين هذه الأعمال من الموقع هناك، ثمّ فوجئ الجميع بنزول اثنين من شبان الجماعة إلى الحدود، والمواجهة مع الجيش الإسرائيلي ومقتلهم، وهو أمرٌ حدث سابقاً في فترات متقطّعة، لكن الجديد الذي استدعى الاهتمام حجم الاحتفال والتأييد للعملية، وتسجيلات مصوّرة وترتيبات مع أفراد آخرين من الجماعة، ثمّ جاءت القضية الأخيرة، لتظهر أنّ المسألة لم تكن معزولةً عن حاضنة داخل الحركة من مجموعات شبابية تفكّر بالطريقة نفسها.
بين هذا وذاك، حصلت تجاوزات خطيرة مهدّدة للوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي خلال المسيرات، مثل اتهام الجيش الأردني والأمن والدولة، وبالرغم من أنّ تلك الحوادث أيضاً فردية وانفعالية، ولم تتعامل معها الدولة بوصفها مسألةً كبيرةً، لكن إذا تمّ ربط الأمور والأحداث الصغيرة وتجميعها معاً، فإنّ هنالك مزاجاً يكرّس مساراً متدحرجاً باتجاهاتٍ تستدعي التوقّف والإيقاف لمصلحة الوطن والجميع.
لنأخذ مسألة العلاقة بين الدولة والجماعة إلى مرحلة أبعد قليلاً، حتى يكتمل إطار الفهم والتحليل بصورة أفضل، ولنتجاوز مرحلة "الربيع العربي"، وتجذّر أزمة الثقة وما قبلها، ولنبدأ منذ 2015، أيّ عندما تدحرجت الأزمة داخل الجماعة والحزب بصورة كبيرة، وأدّى ذلك إلى خروج أغلب أبناء الجناح الموسوم بالاعتدال والواقعية والانفتاح. هنا، استبق المراقب العام الأسبق عبد المجيد ذنيبات، المعروف ببراغماتيته وحنكته، الزمن، وسجّل جماعة جديدة مرخّصة بقانون الجمعيات (بعدما أثيرت مسألة الترخيص القانوني للجماعة قانونياً في البلاد)، وكانت النتيجة اتهامه وتخوينه من عديد من أبناء الجماعة، ثمّ خرج المراقب العام اللاحق سالم الفلاحات وقيادات عديدة من الجماعة والحزب، وأسّسوا أحزاباً جديدة، وبقيت الجماعة مصرّةً على المواجهة القضائية إلى أن جاء قرار قطعي في العام 2020 لصالح إنهاء الوجود القانوني لجماعة الإخوان المسلمين القديمة، ومصادرة الممتلكات، لكن الجماعة بقيت مصرّةً على العمل والوجود، وبقي لها مراقبٌ عام، وشُعَب غير رسمية، وانتخابات ومجلس شورى ومكتب تنفيذي، وتساهلت الدولة مع ذلك لتفضيلها (تاريخياً في الأردن) مبدأ الاحتواء على المواجهة، بالرغم من أن الجماعة اعتُبرت إرهابيةً ومحظورةً، وجرى التعامل معها بقسوة شديدة، في جميع الدول العربية المحيطة.
كان بإمكان الجماعة سابقاً تصحيح المسار، وكانت هنالك طروحات من تيّارات فيها بإمكانية الاندماج والانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين القانونية والمرخّصة، وجميعهم من أبناء الجماعة أصلاً، أو الاكتفاء بحزب جبهة العمل الإسلامي، بوصفه المؤسّسة القانونية الرسمية للحركة، لكن التيّار المتعنّت (ما زال يقود الجماعة) رفض ذلك كلّه، وأصرّ على ازدواجية التنظيم، والجمع بين العملَين القانوني وغير القانوني، وتحدّى الدولة والقضاء والحكومات المتعاقبة بهذا الموقف، وكان المنطق الواقعي والسياسي والحكيم يدفع بهم إلى التفكير في خيارات أخرى، وإلى المرونة وتجنّب الصدام، فضلاً عن أنّ في ذلك مصلحةً وطنيةً، وهو في مصلحة الحركة نفسها لحماية وجودها، وهو ما لم يحصل. استدعاء هذا المنظور التاريخي هو للتذكير فقط بأن ما حدث أخيراً ليس منفصلاً عن سياق متراكم، ومتطوّر في خطّ بياني متصاعد منذ أعوام، وصل اليوم إلى مرحلة من الضروري أن تؤدّي إلى معالجته، وإلى الخروج من رحم هذه الأزمة إلى مرحلةٍ واضحةٍ من العلاقة السليمة، والكرة في ملعب قادة الحركة الإسلامية ليقرّروا ماذا يريدون، هل هم حزب سياسي وطني يعمل تحت أحكام الدستور والقانون، وهم حزب سياسي سلمي ليست لديه أقسامٌ معلنة معروفة وأخرى غير معلنة ولا معروفة، ويؤمن بالعمل السلمي والديمقراطي، ولا يرى في نفسه ندّاً، ولا خارجاً على الدولة ومؤسّساتها وهُويَّتها؟ أم أنّه يريد الإمساك والاحتفاظ بفكرة الجماعة والحزب، والخلط بين الدعوي والسياسي، والعملَين المُعلَن والخفي، ومفهوم البيعة، والدولة، ومفهوم الحزب السياسي، وأن يحمل معه هذه التناقضات والتباينات كلهّا في خطابه وسلوكه؟
المسألة الأخيرة مرتبطة بالجانب الفقهي والشرعي، بخاصّة في ما يتعلّق بمسألة العمل المسلّح واختراق الحدود والتصنيع، وغيرها من مفاهيم مُؤسِّسة لمسار مختلف، لأنّ جمهور الإسلاميين من المتديّنين عموماً، فإنّ القاعدة الفقهية المعروفة في التراث الإسلامي هي الموازنة بين المصالح والمفاسد، وتغليب أدنى المفسدتَين على أعلاهما، وأكبر المصلحتَين على ما دونهما، ودرء الحدود بالشبهات. هذه هي القواعد الحاكمة للفقه السياسي الإسلامي، سواء عند الماوردي أو الإمام الجويني أو حتى ابن تيمية وجلّ الفقهاء. ضمن هذا المنظور الفقهي، فإنّ إهدار رأس المال بحجّة الحصول على ربح أمر غير منطقي، وحماية الدولة والمجتمع والأمن الاجتماعي في الأردن مسألة مقدّمة على تغليب العاطفة، والضفة الغربية بالمناسبة مليئة بالأسلحة. لكنْ، هنالك قرار لدى نسبة كبيرة من الناس بعدم الانخراط في عمل عسكري مع حكومة بنيامين نتنياهو، لتفويت الفرصة عليها في أن تستخدم ذلك لإفراغ الضفة، وتهجير سكّانها قسرياً كما يحدث حالياً في غزّة. إدراك هذا الواقع ومقتضياته، وموازين القوى والتعامل معها، هو لبّ الفقه الإسلامي، وليس خارجاً عنه، والأمور تقاس بمنطق المصالح والمفاسد أردنياً، وليس بمنطق أيديولوجي أو عصابي أو عاطفي فقط.